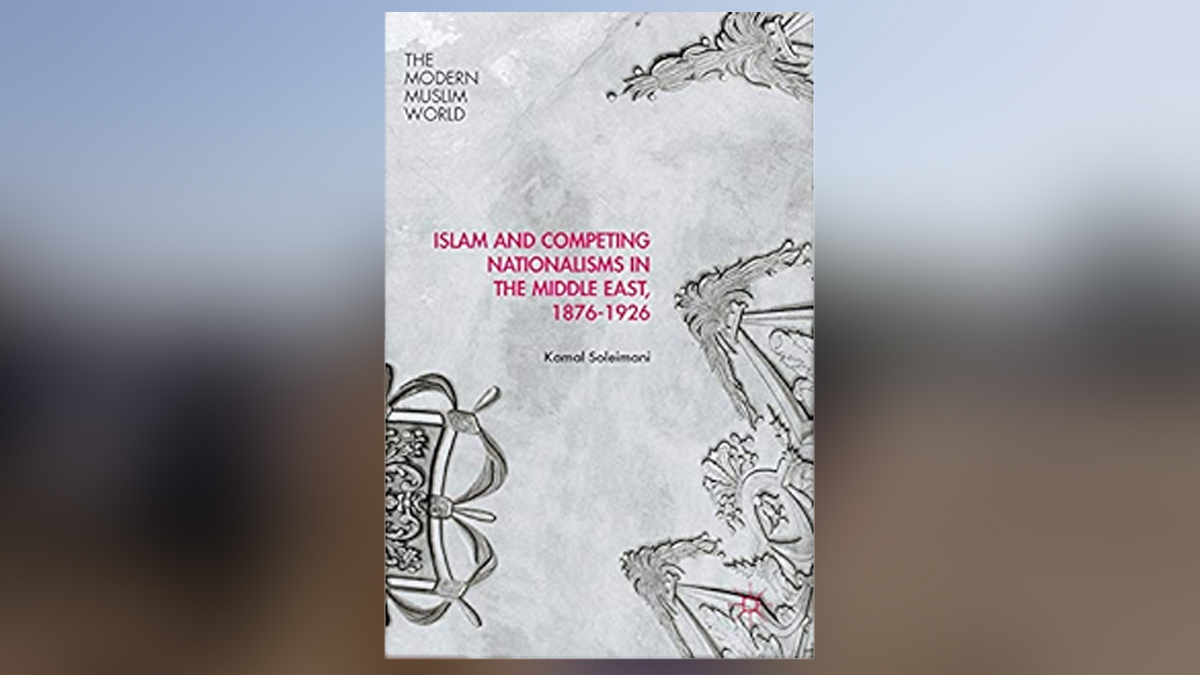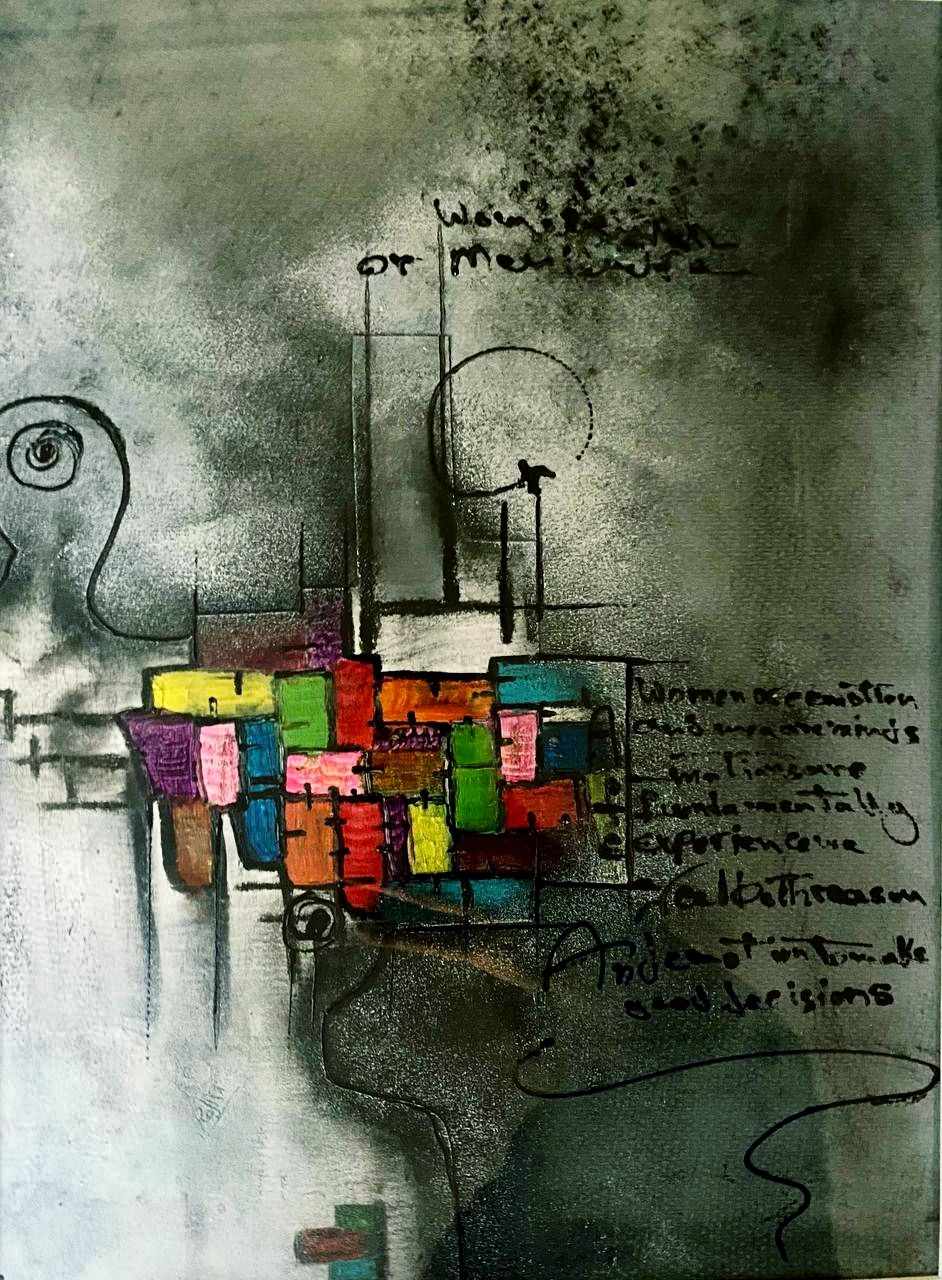مارتن إنديك*
ترجمة: مصطفى إسماعيل
أكدت النهاية المخزية لحرب الولايات المتحدة في أفغانستان إلى حد بعيد على مدى تعقد وهشاشة الشرق الأوسط الكبير. قد يحاول الأمريكان التخفيف عن أنفسهم بأن في وسعهم أخيراً إدارة ظهورهم لهذه المنطقة المضطربة لكون الولايات المتحدة مكتفية ذاتياً من الطاقة الآن وبالتالي أقل اعتماداً على نفط الشرق الأوسط. لقد تعلمت واشنطن بطريقة شاقة ألا تحاول إعادة تشكيل المنطقة وفقاً لرؤية الولايات المتحدة. وإذا كان القادة الأمريكيون يميلون إلى شنّ الحرب هناك ثانيةً، فمن المحتمل أن يجدوا تأييداً شعبياً ضئيلاً.
بيد أن التمحور بعيداً عن الشرق الأوسط الكبير هو في الواقع قولٌ أسهل من الفعل، فإذا استمرت إيران في الدفع قدماً ببرنامجها النووي إلى عتبة تطوير سلاح نووي فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة أو إلى ضربة إسرائيلية استباقية من شأنها جرَّ الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، فالمنطقة لا تزال مهمة بسبب مركزيتها الجيواستراتيجية، ولأنها تقع على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا. تعتمد إسرائيل ويعتمد حلفاء واشنطن العرب في أمنهم على الولايات المتحدة، فيما تظل الدول الفاشلة مثل سوريا واليمن أرض خصبة محتملة للإرهابيين الذين يمكنهم ضرب الولايات المتحدة وحلفائها. ورغم أن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد على التدفق الحر للنفط من الخليج، إلا أن الانقطاع لفترة طويلة عن المنطقة قد يؤدي إلى اضطراب في الاقتصاد العالمي. سَواءً أرَدْنا أمْ لا، تحتاج الولايات المتحدة إلى صياغة استراتيجية لما بعد أفغانستان، لتعزيز النظام في الشرق الأوسط حتى مع تحويلها لتركيزها إلى أولويات أخرى.
هنالك سابقة يمكن أن تستخدم كأنموذجٍ مفيد أثناء صياغة تلك الإستراتيجية. إنها تجربة استراتيجي واشنطن البارز هنري كيسنجر. رغم أنه قليلاً ما يُذكرُ في هذا الخصوص، إلا أن كيسنجر وخلال السنوات الأربع التي شغل فيها منصب وزير الخارجية لرئيسي الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، قاد جهوداً ناجحة لبناء نظام شرق أوسطي مستقر استمر لمدة 30 عاماً. تمكن كيسنجر من تحقيق ذلك بينما كانت الولايات المتحدة تسحب كامل قواتها من فيتنام وتنسحب من جنوب شرق آسيا. كانت لحظة زمنية أشبه باليوم، حين كان على الدبلوماسية أن تحل بديلاً لاستخدام القوة. تزامن ذلك مع فضيحة ووترغيت، التي دفعت بالولايات المتحدة إلى أزمة سياسية عميقة وأجبرت الرئيس نيكسون على التنحي، ما خلق فراغاً محتملاً في القيادة الأمريكية على المسرح العالمي. كذلك، فإنه وخلال فترة الاعتلال الأمريكية تلك في غمرة الحرب الباردة، تمكنت دبلوماسية كيسنجر من تهميش الاتحاد السوفييتي وإرساء الأسس لعملية سلام في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، أنهت على نحو فعال الصراع بين الدول العربية وإسرائيل، رغم فشل العملية في تسوية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
أحد أهم الدروس المستفادة من حقبة كيسنجر أن التوازن/ التكافؤ في ميزان القوى الإقليمي غير كافٍ للمحافظة على نظام مستقر. لشرعنة هذا النظام، تحتاج واشنطن إلى إيجاد سبل لتشجيع حلفائها وشركائها على معالجة مظالم المنطقة الإقليمية. رغم أن صنّاع السياسات ينبغي أن يتوخوا الحذر في جهودهم لصنع السلام، ومنح الأولوية للاستقرار على صفقات إنهاء الصراع، ينبغي عليهم أيضاً تفادي التسرع في إنهاء الصراع، لأن بإمكان ذلك أن يزعزع أيضاً استقرار النظام. في حين أن هناك قابلية محدودة في واشنطن لمعالجة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، فإن على إدارة بايدن مقاومة الميل إلى إهمال القضية. وكما تعلم كيسنجر بمشقة، يمكن للصراعات التي تبدو هامدة أن تندلع في شكل أزمات شاملة في لحظات غير متوقعة. إن التعامل مع أحد الصراعات المركزية في الشرق الأوسط عبر استخدام الاستراتيجية الكيسنجرية القائمة على خطوات تدريجية هو أفضل طريقة لتجنب اندلاع حريق آخر في هذه المنطقة المشتعلة أصلاً.
نظام وليس سلام
ما سعى كيسنجر إلى تحقيقه كان النظام لا السلام، لأنه كان يعتقد أن السلام هدفٌ لا يمكن تحقيقه ولا حتى مرغوباً في الشرق الأوسط. إذ يتطلب الحفاظ على النظام في الشرق الأوسط، من وجهة نظر كيسنجر، الإبقاء على توازن قوى مستقر. في أطروحته للدكتوراة والتي نشرت لاحقاً في 1957 بعنوان “عالم مستعاد” أوضح كيسنجر كيف أن الدبلوماسي النمساوي كليمنس فون مترنيخ ورجل الدولة البريطاني-الإيرلندي اللورد كاسلريه أنتجا 100 عام من الاستقرار النسبي في أوروبا من خلال نزوعهما الذكي إلى توازن القوى و وتلاعبهما بمهارة بأولئك الذين حاولوا الإخلال به.
سعى كيسنجر إلى استنساخ هذا النهج وتطبيقه في الشرق الأوسط عندما أتيحت له الفرصة. لكنه خلص إلى أن التوازن في ميزان القوى لم يكن كافياً. فلكي يكون النظام مستداماً، يجب أن يكون أيضاً مشروعاً، ما يعني أن جميع القوى الكبرى داخل النظام يجب أن تتقيد بمجموعة من القواعد المقبولة. وهذه القواعد لن يتم احترامها إلا إذا وفرت شعوراً كافياً بالعدالة لدى عدد كافٍ من الدول. كتب كيسنجر أن ذلك لا يتطلب معالجة جميع المظالم، بل “مجرد غياب المظالم التي من شأنها أن تحفز على محاولة الإطاحة بالنظام”، وجادل كيسنجر بأن النظام المتمتع بالشرعية لا يقضي على الصراع، لكنه يحدُّ من نطاقه.
توصل كيسنجر إلى هذا الاستنتاج أيضاً من خلال ما لاحظه خلال الحرب العالمية الثانية، عندما أدت المثالية الويلسونية، التي سعت إلى سلام لإنهاء جميع الحروب، إلى المهادنة بدلاً من ذلك واجتياح هتلر لأوروبا. كما أشار كيسنجر في مذكراته “بالنسبة لمعظم الناس في معظم فترات التاريخ، كان السلام حالةً هشة ولم يعني اختفاء كل التوترات خلال الألفية”. نتيجة لذلك، كان كيسنجر، في جهوده الدبلوماسية في الشرق الأوسط، يتجنب باستمرارْ السعي وراء السلام، وكان يسعى عوضاً عن ذلك إلى اتفاقيات من شأنها أن تمنح جميع الأطراف حصة في الحفاظ على النظام الحالي. وقد قال لي بعد عقود، “لم أفكر أبداً بإمكانية أن تكون هناك لحظة مصالحة عالمية.”
تجسد تشكيك كيسنجر لأول مرة في العنوان الفرعي “مترنيخ، كاسلريه، ومشاكل السلام” الذي اختاره لكتابه “عالم مستعاد”. الواقع، أنه وبعد سنوات من البحث المتعمق، خلص إلى أن السلام كان إشكالياً وسوف يكون له تأثير تكويني على مقاربته للدبلوماسية في الشرق الأوسط. يشرح كيسنجر في الصفحة الأولى من مقدمة كتابه “عالم مستعاد” سبب توصله إلى هذه الخلاصة، إذ يكتب: “إن تحقيق السلام ليس سهلاً كما الرغبة في تحقيقه”. واتضَّح له من باب المفارقة أن حقباً مثل تلك الفترة التي درسها كانت الأكثر سلمية لأن رجال الدولة المعنيين لم يكونوا منشغلين بإقامة السلام.
كان الفيلسوف الألماني من القرن الثامن عشر إيمانويل كانط العامل المؤثر الآخر على صناعة كيسنجر للسلام في الشرق الأوسط. كان كانط يعتقد أن السلام أمرٌ لا بد منه. لكن ما أخذه كيسنجر من مقال كانط “السلام الدائم” هو أن الصراع بين الدول سيؤدي بمرور الوقت إلى استنزاف قواها. وفي نهاية المطاف، سوف يفضلون السلام على مأساة الحرب. بتعبير آخر، فإن صنع السلام عملية تراكمية لا يمكن استعجالها. وكما لاحظ كيسنجر فإن كانط فهِمَ أن “المعضلة الجذرية في عصرنا هي أنه إذا تحول السعي من أجل السلام إلى الهدف الوحيد للسياسة، فإن الخوف من الحرب يصبح سلاحاً في أيدي الناس الأكثر قسوة، وينتج نزعاً أخلاقياً”.
حين طبق كيسنجر هذا المنظور على الشرق الأوسط، افترضَ أن العرب ليسوا مستعدين للتصالح مع الدولة اليهودية، وأن إسرائيل غير قادرة على تقديم تنازلات عن الأراضي التي طالب بها العرب دون تعريض وجودها للخطر. لذا فإنه طوّر عملية سلام أتاحت لإسرائيل الانسحاب بخطوات صغيرة وتدرجية من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب الأيام الستة عام 1967. وقد أُضفيتْ الشرعية على هذا النهج في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 الذي نصَّ على تبادل الأراضي مقابل السلام.
غير أن عملية سلام كيسنجر قد صُممتْ لكسب الوقت بدلاً من إحلال السلام: وقتٌ لإسرائيل يمكنها من بناء قدراتها وتخفيف عزلتها، ووقتٌ للعرب يصيبهم بالملل من الصراع والاعتراف بمزايا العمل مع جارٍ إسرائيلي قوي على نحو متزايد. كان كيسنجر، في غضون ذلك، يسعى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بحذر وتشكيك وتدرجية، ولهذا أطلق على العملية تسمية “دبلوماسية الخطوة- خطوة”.
كان التوازن ومشروعية السعي وراء النظام والتدرجية في السعي لتحقيق السلام هي المفاهيم الأساسية في نهج كيسنجر الاستراتيجي. لقد تمكن من التفاوض على ثلاث اتفاقيات مؤقتة بين مصر وسوريا وإسرائيل، ووضع الأسس لمعاهدات السلام اللاحقة التي أبرمتها إسرائيل مع مصر والأردن. لكن عمليته للسلام رغم ذلك بدأت بالانهيار وذلك حين تجاهل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون تأكيد كيسنجر على الحذر، وحاول وفشل في إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ثم شن الرئيس جورج دبليو بوش غزوه المشؤوم للعراق، وزعزع استقرار نظام كيسنجر من خلال تمكين إيران الثورية من تحدي الهيمنة الأمريكية في العالم العربي السني.
بمساعدة بسيطة من أصدقائنا
إن المقاربة التي اعتمدها كيسنجر في الشرق الأوسط مهمةٌ بشكل خاص في الوقت الحاضر. فالولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط اليوم في تماثل واضح مع انسحاب الولايات المتحدة من جنوب شرق آسيا في زمن كيسنجر. حينها، كما الآن، أدت تداعيات حرب فاشلة وطويلة الأمد إلى فرض قيود صارمة على قدرة واشنطن على نشر القوة في الشرق الأوسط. رغمها، كان كيسنجر يعلم أن توازناً مستقراً يعتمد على دعم الولايات المتحدة لدبلوماسيتها والتهديد الموثوق بالقيام بعمل عسكري. لقد قام بعمل مستحيل عبر الاعتماد على شركاء إقليميين مؤهلين والعمل معهم.
على سبيل المثال، سعت منظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1970 للإطاحة بالملك حسين في الأردن. دعمت ثلاثة ألوية دبابات سورية مدعومة من الاتحاد السوفييتي محاولة المنظمة في احتلال مدينة إربد شمال الأردن. خوفاً من تقدمهم باتجاه عمان، دعا الملك حسين واشنطن للتدخل، لكن لم يكن بإمكان الولايات المتحدة التحرك بسرعة، وتخاطر بالتعثر هناك إذا تدخلت. لذا لجأ كيسنجر، بناءً على إلحاح من حسين وبدعم مرتقب من نيكسون، إلى إسرائيل لردع السوريين. أمرت رئيسة الوزراء غولدا مائير جيش الدفاع الإسرائيلي بالتعبئة في مرتفعات الجولان وعلى الحدود الأردنية بمحاذاة إربد. في غضون ذلك ولأجل ردع السوفييت، نشر كيسنجر مجموعتين من حاملات الطائرات المقاتلة الأمريكية قبالة الساحل اللبناني وأمر مجموعة ثالثة بدخول البحر المتوسط. بتشجيع من الدعم الإسرائيلي والأمريكي، ألحق الجيش الأردني خسائر فادحة بألوية الدبابات السورية وانسحب السوريون. في غضون أيام، كانت الأزمة قد انتهت دون وجود جندي أمريكي واحد على الأرض.
استفاد كيسنجر أيضاً من دعم الحلفاء الإقليميين في التعامل مع الزعيم القومي المصري جمال عبد الناصر. عندما دخل كيسنجر البيت الأبيض في 1969 كمستشار للأمن القومي للرئيس نيكسون، كان عبد الناصر يعد قالباً ثورياً يسعى إلى الإخلال بالنظام القائم في الشرق الأوسط على النحو الذي تحدى به نابليون النظام الأوروبي في بداية القرن التاسع عشر. في التعامل مع مناورة عبد الناصر المدعومة من السوفييت، تحاشى كيسنجر سياسة تغيير النظام الحاكم، وهي السياسة التي اتبعتها فرنسا والمملكة المتحدة خلال أزمة السويس عام 1956 لكن كانت النتائج كارثية. بدلاً من ذلك، سعى كيسنجر إلى احتواء عبد الناصر من خلال تعزيز توازن القوى لصالح المدافعين الإقليميين عن الوضع القائم: إسرائيل في قلب الشرق الأوسط، وإيران والمملكة العربية السعودية في الخليج العربي. عززت سياسة الانفراج/ الوفاق التي طورها نيكسون وكيسنجر مع الاتحاد السوفييتي هذا التوازن لأنها انطوت، من بين جملة أمور، على التزام مشترك من قبل القوتين العظميين بالحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.
أقرَّ كيسنجر بأنه يتعين على واشنطن دراسة مطالبة الدول العربية بالعدالة في أعقاب حرب الأيام الستة التي خسرت فيها أراضي مهمة في مواجهة إسرائيل. إن عدم القيام بذلك سيهدد شرعية النظام الشرق أوسطي الجديد. رغم ذلك، فقد افترض أنه طالما حافظت القوى العظمى على توازن في ميزان القوى الإقليمي فإنه يمكن إرجاءُ العدالة. لقد أساء التقدير في ذلك كما تبين بعد اندلاع حرب يوم كيبور/ يوم الغفران عام 1973.
في الفترة التي سبقت هذه الحرب، اعتمد كيسنجر على تقييمات استخباراتية إسرائيلية وأمريكية مفادها أن مصر لن تخاطر أبداً في شن الحرب لأن إسرائيل المتفوقة عسكرياً والمدعومة بأنظمة الأسلحة الأمريكية المتطورة ستهزمها بسرعة. أدى هذا التحليل بكيسنجر إلى تجاهل خليفة عبد الناصر، أنور السادات، الذي حذّر مراراً من أنه سيخوض الحرب إذا ما تم تجاهل تطلعات مصر في استعادة الأراضي التي فقدتها خلال حرب 1967. نحّى كيسنجر تصريحات السادات جانباً حتى عندما صدرت في لهجة مخيفة: في إحدى المقابلات، مثلاً، أعلن الزعيم المصري أنه “تتم الآن التعبئة بجدية في كل المجالات في هذا البلد لاستئناف المعركة، وهو أمر لا مفر منه الآن”.
رغم ذلك، حين غزت مصر شبه جزيرة سيناء وحاولت سوريا استعادة مرتفعات الجولان في أقدس يوم في التقويم اليهودي في عام 1973، انطلق كيسنجر للعمل بثقة وفرتها له دراسته للنظام الأوروبي في القرن التاسع عشر. كان هدفه تعديل ترتيبات ما قبل الحرب بطريقة يرى فيها الفاعلون الرئيسيون في الشرق الأوسط أنها أكثر عدلاً وإنصافاً. كما أراد أن يمنح الولايات المتحدة وضعاً يمكنها من لعب دور المناور المهيمن على القوى المتنافسة في المنطقة.
لدعم دبلوماسيته بالقوة، شجع كيسنجر هجوماً إسرائيلياً مضاداً. عندما ساعد ذلك الضغط العسكري في حث المصريين والسوفييت على قبول شروطه لوقف إطلاق النار، طالب إسرائيل بوقف هجومها. ومنع، تحديداً، جيش الدفاع الإسرائيلي من تدمير الجيش المصري الثالث الذي كان قد حاصره في نهاية الحرب. مكن ذلك السادات من الدخول في مفاوضات سلام في وضع بقي فيه نظامه وكرامته مصونين.
انتهز كيسنجر لاحقاً مرونة اللحظة لإطلاق عمليته للسلام بهدف منع مصر- أكبر دولة عربية وأقواها عسكرياً- من الانضمام إلى أي تحالف حرب عربي مستقبلي، ومن شأن ذلك أن يجعل أي حرب أخرى بين الدولة اليهودية والدول العربية أمراً غير ممكن. هناك تماثل لا لبس فيه بين مقاربة كيسنجر لمصر والطريقة التي تعامل بها كل من ميترنيخ وكاسلريه مع فرنسا بعد هزيمة نابليون، بدمج فرنسا في النظام الجديد بدلاً من معاقبتها، وبالتالي تحويلها من دولة ثورية تعديلية إلى قوة في الوضع القائم.
اليوم، من المرجح أن يستخدم كيسنجر خطة مماثلة في التعامل مع إيران، الدولة التي تهدد بشكل واضح للغاية ما تبقى من النظام الشرق أوسطي الذي تقوده الولايات المتحدة. هو لن يدعو إلى إسقاط النظام، بل سيسعى إلى إقناع إيران بالتخلي عن مسعاها في تصدير ثورتها والعودة بدلاً من ذلك إلى انتهاج سلوك الدولة. أثناء ذلك، يجب على واشنطن أن تسعى إلى توازن جديد يتم فيه احتواء الاندفاعات الإيرانية الثورية وموازنتها من خلال تحالف من الدول السنية المتعاونة مع إسرائيل والولايات المتحدة. حين تقرر إيران اتباع قواعد اللعب، يعتقد كيسنجر أن الولايات المتحدة سوف تكون بحاجة إلى أن تكون بمثابة عامل توازن، متموضعة على المسافة القريبة نفسها من جميع القوى الشرق أوسطية المتنافسة فيما بينها. يقول كيسنجر: “متبعة أهدافها الإستراتيجية، يمكن للولايات المتحدة أن تصبح أحد العوامل الحاسمة – ربما العامل الحاسم الوحيد – في تحديد ما إذا كانت إيران ستمضي في مسار الإسلام الثوري أو تمضي في مسار أمة عظيمة تستقر بشكل شرعي ومهم في نظامٍ ويستفالي من الدول”.
احذر من هدف بعيد المنال
لأنه كان يدير عمله في بيئة متخندقة، كان كيسنجر مدركاً تماماً لمخاطر تجاوز الحدود، لكن كما يذكر في كتابه “عالم مستعاد”: “ليس التوازنُ ما يُلهم الرجال، بل العالمية، وليس الأمن، بل الخلود”. وكما أوضح في كتابه الضخم “الدبلوماسية”، الذي نُشر عام 1994، فإن رجال الدولة الأمريكيين قلما يفهمون أو يحترمون قواعد اللعبة التي يتطلبها مفهومه عن النظام الدولي. إذ غالباً ما تكون مثالياتهم مدفوعة بشعورٍ بالتدابير الإلهية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط. إنهم يتصورون أن السعي من أجل السلام وبناء الأمة ليس فقط أمراً مرغوباً فيه، ولكن من الممكن تحقيقه، وأن المشكلة الوحيدة هي التوصل إلى الصيغة الصحيحة. وهنا تكمن المعضلة في قلب الدبلوماسية الأمريكية للشرق الأوسط. كما فهم كيسنجر، فإن الحفاظ على النظام يتطلب مجهوداً يتحلى بالمصداقية لحل نزاعات المنطقة، لكن حجم طموح رجل الدولة يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار هذا النظام.
انظر كيف كان انطباع نيكسون الأول حيال العمل مع الاتحاد السوفييتي لفرض السلام على وكلائهم المتعنتين في الشرق الأوسط. طار كيسنجر إلى موسكو في منتصف حرب يوم الغفران للتفاوض على شروط وقف إطلاق النار مع الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف. تلقى في طريقه إلى موسكو تعليمات واضحة من نيكسون بـ “بذل كل الجهود” لإنجاز تسوية عادلة “حالاً” والعمل مع بريجنيف “لممارسة الضغط اللازم على أصدقائنا المعنيين”. وقد هدد ذلك بقلب استراتيجية كيسنجر الأكثر تواضعاً في وقف إطلاق النار تليها مفاوضات مصرية إسرائيلية مباشرة. غاضباً، تجاهل كيسنجر تعليمات الرئيس. كان كيسنجر قادراً على القيام بذلك لأن نيكسون كان قد أرسل هذه الرسالة بالتزامن مع أمره بإقالة المدعي الخاص في قضية ووترغيت، أرشيبالد كوكس. أدت “مجزرة ليلة السبت” التي أعقبت ذلك، والتي استقال فيها اثنان من كبار مسؤولي وزارة العدل بدلاً من تنفيذهم لأمر نيكسون، إلى بدء قادة الكونغرس لإجراءات عزل الرئيس. مع تركز كل الانتباه على السياسة الداخلية للولايات المتحدة، تمكن كيسنجر أثناء ذلك من متابعة أولوياته في الشرق الأوسط.
لقد نجح في إنجاز مشابه تحت قيادة فورد خليفة نيكسون، فحين انهارت المفاوضات بين السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في فبراير 1975، أراد فورد عقد مؤتمر في جنيف مع الاتحاد السوفييتي لفرض تسوية سلمية شاملة على إسرائيل وجيرانها العرب. قاد كيسنجر هذه المبادرة لصالح العودة إلى دبلوماسيته المكوكية، التي جعلت مصر وإسرائيل أقرب إلى اتفاق سلام نهائي بينهما.
كان رؤساء الولايات المتحدة الذين أتوا بعد نيكسون وفورد يميلون أيضاً لمواصلة تحقيق أهدافهم المثالية في الشرق الأوسط مع اهتمام غير كافٍ بالحفاظ على النظام الإقليمي الذي أنشأه كيسنجر. فالرئيس جيمي كارتر أحيا فكرة العمل مع الاتحاد السوفيتي لاستئناف العمل على عقد مؤتمر جنيف لفرض سلام شامل. لكن هذه المرة كان السادات هو الذي قاد الرئيس الأمريكي من خلال زيارته إلى القدس في نوفمبر 1977. سعى كارتر بعد ذلك بعام في كامب ديفيد إلى اتفاق سلام مصري-إسرائيلي منفصل بدلاً من تسوية شاملة كانت ستشمل حلاً للمشكلة الفلسطينية.
بعد أكثر من عقدين من ذلك التاريخ، استجاب كلينتون لإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك في محاولة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في كامب ديفيد في يوليو 2000، متخلياً عن العملية الكيسنجرية “خطوة بخطوة” والتي كان رابين قد أخذ بها وأدرجها في اتفاقيات أوسلو. فهم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن باراك وكلينتون يعتزمان فرض حل نهائي على الفلسطينيين، لذا رفض الذهاب بعيداً. كان هناك فاصل زمني قصير بين كامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وحملة القمع الإسرائيلية اللاحقة. كانت الانتفاضة صراعاً متأججاً عنيفاً استمر لمدة خمس سنوات، أدت إلى مقتل الآلاف، ودمرت الثقة بين الطرفين. رغم ذلك، فإن الرئيسين الأمريكيين باراك أوباما ودونالد ترامب سيحاولان أيضاً لاحقاً ويفشلان في إبرام اتفاقيات لإنهاء الصراع.
قاوم بوش إغواء صنع سلام شامل، لكنه تأثر بالحاجة إلى تحقيق ما أسماه كيسنجر منذ زمن بعيد بـ “الخلود”/ الحفاظ على النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. بعد الإطاحة بطالبان في أفغانستان وصدام حسين في العراق، أعلن بوش عن “أجندة الحرية” في الشرق الأوسط، معلناً أن تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة “يجب أن يكون محور السياسة الأمريكية لعقود قادمة”. كانت النتيجة كارثية، إذ مهد ذلك في الغالب الطريق لمحاولة إيرانية للهيمنة على العراق وعلى جميع أنحاء المنطقة. كما حوَّل بوش هدف الولايات المتحدة في أفغانستان من مكافحة الإرهاب إلى مكافحة التمرد وبناء الدولة، وقد أدى هذا القرار كذلك إلى الفشل والمذلة. بعد عشرين عاماً، تُرك الأمرُ للتسعيني كيسنجر ليبين أن “الأهداف العسكرية كانت إطلاقية للغاية ولا يمكن تحقيقها، والأهداف السياسية عبثية للغاية وبعيدة المنال”.
خطر الطموح البسيط
على النقيض من صانعي السياسة الأمريكيين الذين جاؤوا من بعده، كان كيسنجر مصمماً على تفادي التمادي في الشرق الأوسط، لكن كانت هناك عدة مناسبات أدى فيها حذره وشكه إلى وصول محدود إلى أهدافه. وذلك هو الخطر الذي يواجهه أيضاً الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط الآن بعد أن أنهى الحرب في أفغانستان.
بالنسبة لكيسنجر، جاءت أولى محاولات التطلع إلى هدف دونَ الطموح في يوليو 1972، عندما أعلن السادات فجأة طرد 20 ألف مستشار عسكري سوفييتي من مصر. كان ذلك أمراً قد دعا إليه كيسنجر قبل عامين من ذلك التاريخ، ولكن عندما حدث الأمر، لم يكلف كيسنجر نفسه عناء التعاطي مع الحدث.
كان السادات محبطاً. إذ أنه كان قد أرسل رسالة إلى كيسنجر قبل خمسة أيام من إعلان الطرد معرباً فيها عن رغبته في إيفاد مبعوث خاص إلى واشنطن. لكن الأمر سيتطلب من كيسنجر سبعة أشهر للردّ عبر ترتيب لقاء مع حافظ إسماعيل، مستشار الأمن القومي للسادات. استحوذ العرض التقديمي الذي قدمه إسماعيل على اهتمام كيسنجر. أوضح المبعوث المصري في عرضه أن بلاده مستعدة للتحرك بسرعة، قبل الدول العربية الأخرى، وسوف تقرُّ بقاء وجود أمني إسرائيلي في سيناء حتى، ولكن شريطة أن تعترف إسرائيل بالسيادة المصرية على المنطقة.
لكن حين أطلع كيسنجر رابين، الذي كان حينها سفير غولدا مائير في واشنطن، رفض رابين عرض إسماعيل ووصفه بأن “لا جديد فيه”. رفضت مائير أيضاً العرض المصري، واستبعد كيسنجر بهدوء الفكرة. التقى إسماعيل بكيسنجر مرة أخرى في مايو لكنه خرج من الاجتماع باعتقادٍ مفاده أن وقوع أزمة فقط هو ما سيغير من حسابات كيسنجر. بعد أربعة أشهر، شن السادات حرب يوم الغفران.
لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان رد أكثر فعالية من كيسنجر كان بإمكانه أن يؤدي إلى وقف الحرب أم لا. ما هو واضح أنه لم يحاول ذلك نظراً لثقته الخاطئة باستقرار التوازن الذي أقامه في المنطقة. لقد أغفل كيسنجر على الصعيد العملي أمراً كان قد سلم به على الصعيد النظري: يعتمد استقرار أي نظام دولي “على درجة شعور مكوناته بالأمان ومدى اتفاقها على عدالة و إنصاف الترتيبات القائمة”. وهذا ما جعله يقرر بعد الحرب تناول العجز في العدالة من خلال إطلاق مفاوضات مباشرة تؤدي إلى انسحابات إسرائيلية من الأراضي العربية.
رغم ذلك لم تكن العدالة من أجل الفلسطينيين على أجندة كيسنجر، ذلك لأنهم كانوا ممثلين من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت حينها فاعلاً بدون دولة ومنظمة انفصالية تعتمد أساليب إرهابية في محاولة الإطاحة بالمملكة الهاشمية في الأردن واستبدال الدولة اليهودية بأخرى فلسطينية. لذا فإن كيسنجر فضل ترك القضية الفلسطينية لإسرائيل والأردن. أدى حذره والحالة هذه إلى إضاعة فرصة ظهرت عام 1974 لتعزيز دور الأردن في معالجة المطالب الفلسطينية. كانت تلك هي آخر لحظة كان من الممكن أن يتم فيها معالجة المشكلة الفلسطينية في مفاوضات بين دولتين، إسرائيل والأردن.
كان للأردن حينها علاقة خاصة بفلسطينيي الضفة الغربية، الذين كانوا مواطنيها. كان للمملكة الهاشمية أيضاً مؤسسات حكومية عاملة، بما في ذلك جيش موثوق به ومنظمة استخباراتية فعالة، يعزى الفضل في ذلك جزئياً للبريطانيين. بخلاف منظمة التحرير الفلسطينية، التي دخلت عملية السلام في عام 1993 بدون مؤسسات حكومية، كان بإمكان الأردن ضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إسرائيل، كما فعل مع التزاماته في معاهدة السلام مع إسرائيل. ومن تلك النقطة كان يمكن أن يتطور اتحاد كونفدرالي بين دولة فلسطينية في الضفة الغربية والمملكة الهاشمية على الضفة الشرقية لنهر الأردن.
لبلوغ ذلك الهدف، كان على كيسنجر أن يسعى إلى اتفاق فك ارتباط بين إسرائيل والأردن بعد أن عقد الاتفاقات بين إسرائيل ومصر من جهة، وإسرائيل وسوريا من جهة أخرى. كان الملك حسين متطلعاً إلى استعادة موطئ قدم في الضفة الغربية، وكان الإسرائيليون على استعداد للانخراط في ذلك وحتى إظهار بعض المرونة أيضاً. لكن كيسنجر تفادى مراراً الانخراط في هذا الجهد، وبدلاً من ذلك حث الملك حسين على التعامل مباشرة مع الإسرائيليين، وهو ما فعله الملك. حذر كيسنجر الإسرائيليين من أنهم إذا لم يستجيبوا فسينتهي بهم الأمر إلى التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكان ذلك توقعاً استشرافياً. لكن بعد ذلك، أصرَّ مراراً على أنه لن يكون هناك ضغط منه و “لا يوجد سبب لتكون [الولايات المتحدة] وسيطاً”.
لم يكن بوسع الإسرائيليين والأردنيين التوصل إلى اتفاق بدون انخراط أمريكي. في أكتوبر 1974، أعلنت جامعة الدول العربية في قمتها في الرباط/ المغرب أن منظمة التحرير الفلسطينية هي “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، ما وضع حداً لفرصة حل المشكلة الفلسطينية في سياق أردني. وقد أقر كيسنجر لاحقاً بشكل صريح أنه ارتكب “خطأ كبيراً”.
كانت لدى كيسنجر أسبابه. فبالرغم من أنه كان معجباً بالملك، إلا أنه لم ينظر إلى الأردن كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط، وكان يعتقد أن ذلك يعني أنه لا يحتاج إلى بذل مجهود دبلوماسي نيابة عنه. بدلاً من ذلك، كرس كيسنجر وقته لاتفاق مصري-إسرائيلي ثان، لأن إخراج مصر من الصراع مع إسرائيل كان هدفه الاستراتيجي الرئيسي. لكن كان من شأن متابعته للخيار الأردني أن يتداخل مع هدفه الاستراتيجي الرئيسي، وربما كان من شأن ذلك أن يثير صراعاً بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان من الممكن أن يطرح مسألة من سيسيطر على القدس، وهي قضية خلافية حادة سعى كيسنجر إلى تفاديها بأي ثمن. ساعد إيمان كيسنجر بهرمية القوة على تحديده الأولويات، ولكن كان ذلك يعني أيضاً أنه لم يولِ سوى النذر اليسير من الاهتمام بالطريقة التي يمكن بها للدول الأقل قوة وحتى الجهات الفاعلة من غير الدول أن تعطل نظامه الذي حققه بصعوبة، سيما إذا ما كان النظام الذي ساعد في وضعه لا يوفر لهم الحد الأدنى من العدالة في أقل تقدير.
علامات التحذير القادمة
يمكن لعثرات كيسنجر وإنجازاته أن تقدم دروساً قيّمة لـ بايدن وهو يتعامل مع الشرق الأوسط في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. بينما يحول بايدن انتباهه إلى أولويات أكثر إلحاحاً في أماكن أخرى، يجب أن يكون هدف دبلوماسيته في الشرق الأوسط تشكيلُ نظام إقليمي مدعوم من الولايات المتحدة. نظامٌ لم تعد فيه الولايات المتحدة هي الفاعل المهيمن، حتى وإن كانت لا تزال الأكثر نفوذاً. سوف يحتاج هذا النظام في جوهره إلى توازن قوى مُحافظٌ عليه من خلال دعم الولايات المتحدة لحلفائها الإقليميين، أي إسرائيل والدول العربية السنية.
لكن بايدن سيحتاج أيضاً إلى العمل مع الفاعلين المستعدين للعب أدوار بناءة في استقرار نظام الشرق الأوسط. من شأن ذلك أن يجعل بعض الشركاء غريبين وغير مرتاحين، إذ سيتضمن ذلك التعاون مع عبد الفتاح السيسي المصري في غزة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الخليج، ومع جميعهم لاحتواء طموحات إيران في الهيمنة والمضي قدماً ببرنامجها النووي.
قلة من هؤلاء الحلفاء والشركاء سوف يتوافقون مع قيم الولايات المتحدة. لكن، وكما تظهر تجربة كيسنجر في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى تعزيز شعور كافٍ بالعدالة والإنصاف لشرعنة النظام الناشئ. في جميع أنحاء المنطقة يصرخ الناس مطالبين بحكومات خاضعة للمساءلة. لا يمكن للولايات المتحدة أن تأمل في تلبية هذه المطالب. فمن شأن ذلك أن يُعدّ مرة أخرى تجاوزاً للحدود، لكنها لا تستطيع كذلك تجاهلها أيضاً.
وعلى نحو مماثل، فإن تعزيز عملية سلام تعمل على تخفيف حدة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني سيكون مهماً في معالجة مظالم المنطقة. يقع ذلك في أدنى قائمة أولويات بايدن. ففي عام 2014 وكنائب للرئيس، شهد بايدن مباشرة عدم رغبة قادة إسرائيليين وفلسطينيين في المخاطرة المعقولة من أجل السلام، وهو لا يتصور أنه سيحظى بالخلود من خلال محاولة إجبارهم على القيام بذلك. إنه يقبل حجة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن ائتلاف حكومي يميني-يساري في إسرائيل لا يمكن أن ينجو من عملية سلام تتطلب إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. يفترض بايدن، مثل كيسنجر في عام 1973، أن الوضع الراهن مستقر، ويرى، مثل كيسنجر في عام 1974، أن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة إسرائيلية للتعامل معها وسيميل إلى وضع أي ضغوط لمحاولة حلها جانباً.
لكن علامات التحذير قائمة، فالسلطة الفلسطينية على وشك الانهيار: فقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس كامل مصداقيته لدى الشعب الفلسطيني، فيما تكسب حماس الشعبية من خلال عقيدتها في المقاومة العنفية. من شأن انتصار طالبان في أفغانستان أن يعزز حجة حماس حول أن استراتيجيتها هي السبيل الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، فإن تعداد الوفيات الفلسطينية من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي يتصاعد بوتيرة مرعبة. وللمرة الأولى، تسمح الحكومة الإسرائيلية لليهود بالصلاة في ما يعرف لدى اليهود بجبل الهيكل ولدى المسلمين بالحرم الشريف- وهي حركة ملهبة للمشاعر إلى حد بعيد. إن الوضع دقيق جداً وقابل للاشتعال في أي لحظة، فمجرد عملية هروب من السجن من قبل ستة سجناء فلسطينيين في سبتمبر حملت تهديداً بإشعال انتفاضة أخرى.
طوال سنوات، حذر واضعي السياسات الأمريكان من أن الوضع القائم الإسرائيلي-الفلسطيني غير قابل للاستمرار- رغم ذلك يبدو أنه مُحافظٌ على نفسه. حذر خبراءٌ من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكن عندما فعل ترامب ذلك لم يحدث شيء. يبدو الأمر كما لو أنه حدث في سبعينيات القرن الماضي وذلك حين هدد السادات بالحرب لسنوات، ولم يحدث شيء- إلى أن حدث ذلك في يوم من الأيام. لتقليل احتمال اندلاع العنف، سوف يحتاج بايدن إلى تشجيع عملية سلام إسرائيلية-فلسطينية تراكمية لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعايش العملي، تماماً كما فعل كيسنجر في جهوده لإخراج مصر من الصراع مع إسرائيل. اقترح بينيت تغييرات اقتصادية كخطوة أولية مثل السماح لمزيد من الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل. لكن مثل هذه التحركات وحدها لن تكون كافية لإضفاء المصداقية على عملية سلمية امتهنتها الإخفاقات السابقة. تتطلب الجهود عملية سياسية أيضاً، وإن كانت عملية متواضعة وواقعية تشمل وقفاً لإطلاق نار طويل الأمد في غزة ووضع بعض المناطق الأخرى على مراحل تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة في الضفة الغربية.
في أعقاب الانسحاب من أفغانستان، من غير المرجح أن يُحدثَ بايدن تجاوزاً في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كما يمكن أن يخبره كيسنجر فإنه سيكون من الخطأ أيضاً أن يدير ظهره للمنطقة.
*مارتن إنديك: ديبلوماسي أمريكي سابق، وباحث في مجلس العلاقات الخارجية، وصدر له مؤخراً كتاب “سيد اللعبة: هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط Master of the Game: Henry Kissinger and the Art of Middle East Diplomacy (Knopf, 2021).
المصدر: