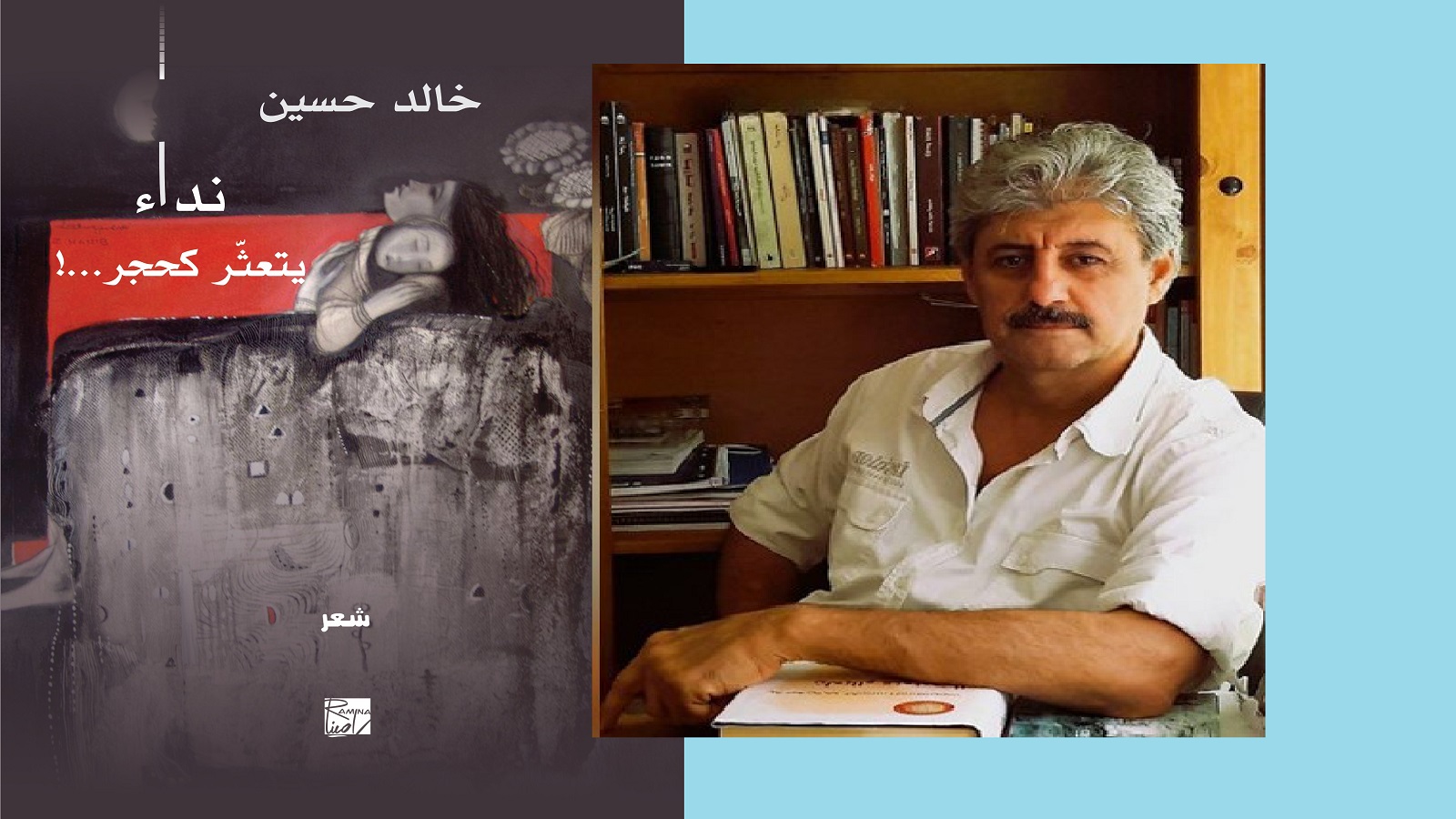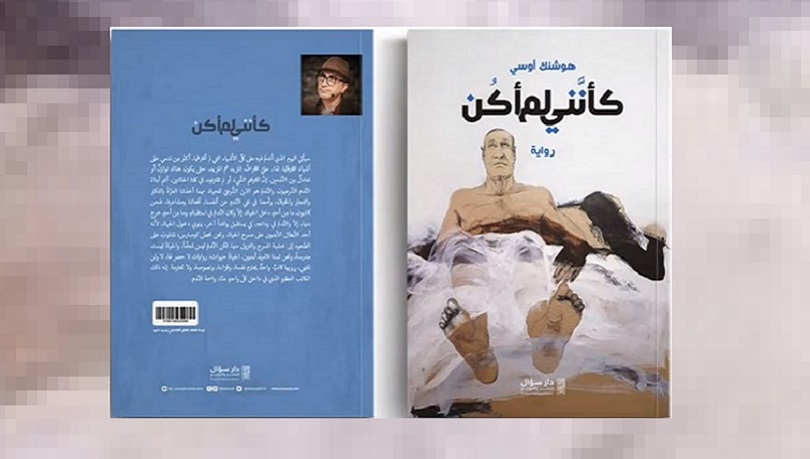لنسأل في البدء من هو الكاتب؟
من المهم القول أولاً، لا توجد حياة بدون قصص أو أحداث. من هنا نحن بحاجة إلى فصل السيرة الذاتية والسيرة العامة. باختصار، يمكن كتابة سيرة ذاتية عن شخص آخر، قد يكون على قيد الحياة، يحدث أيضاً أن صاحب البلاغ يروي الأحداث وهو حاضر في محتواها. في هذه الحالة، يكون الشخص أحداً مصنفا من بين آخرين. قصة حياته هنا ليست محوراً رئيساً، لكن الكاتب ينوي سرد الأحداث بنفسه. الكاتب في هذه الحالة يغدو واحداً من الأحداث، أو ربما شاهد عيان. الكتابة الذاتية، بشكل عام، تركز على إعادة سرد الحدث الحقيقي لحياة شخص ما. ينقب وينبش عن تلك الحياة كأنها مجهولة له، ويبادر بتفحصها بعناية ليكتبها. لذا في هذا النوع من الأدب، إذا وضعنا جانباً كل ما قام الحسيني بذكره عن حياته، من لقاءات، العودة واللاعودة إلى المكان، الظاهر والمخفي والمكنون، المسافة من الأشياء والناس ورؤيتهم من جديد، زيارة الأضرحة، الإعلام، المجلات والصحف الكردية والعربية، المطابع، الشوارع وأشخاص لا معدودين في كل أنحاء المعمورة، سنجد أن الوصف طاغٍ على كل حركة قام بها في الماضي أو في الحاضر، مما يدعونا إلى اعطاء النص تسمية سيرة ذاتية وموضوعية.
قبل الخوض في الإجابة على سؤال لماذا تلك التسمية؟ أتساءل: كيف نقيم أفضل سيرة ذاتية؟
بالطبع هي التي تجذب القراء إلى أحداث مهمة في حياة كاتبه أو رؤيته لأحداث عالمية تركت آثارها كضربات على ظهر البشرية. تشترط فيها اثارة اهتمام القارئ؟ نعم، لكنها ليست الحافز الوحيد لقراءة النص، بل أهمية الأحداث تفرض نفسها وتستوجب خصوصية، اجتماعياً وسياسياً وفنياً وأدبياً وتعليمياً وعلمياً وما إلى ذلك. على سبيل المثال، نص ما تعلمنا المقاومة، ومن قراءة أحدات كتاب نقف على لحظات الألم والمعاناة لكاتبه حيال حياته أو ما مرّ به، ربما نخوض تفاصيل دقيقة في حياة مؤلف ما، قد يكون مع مرض عضال، أو نستكشف أسراراً عالمية كانت مخفية، كما هي الحال مع بعض أسرار الجواسيس…
في هذه السيرة، نلتمس بالدرجة الأولى معاناة الغربة والمنفى. ثم اهتمام الكاتب بالأماكن والمدن والثقافات والحضور التاريخي، إذ نرجع معه باستمرار للماضي، ويعود بنا في صفحات أخرى للحاضر، لكنه، لا يكف عن المقارنة بين الذي مضى والمعاش، وأحياناً ما يتخيله آتياً، فيدون كل شيء، ومن لحظة وجوده في الغرب: “(…) أي، أن أكون واضحاً فيما سأكتبه، بعيداً عن التهويمات الشعرية، بعيداً عن غير الذي أعيشه، لأدوِّن المدينة، إذاً؛ فدونتها. فكان التدوين ـ الكتاب، شعراً ألماً.”(ص15). وفي موضع آخر من الكتاب (ص198) حين ينقل لنا محمد عفيف الحسيني، نحن القراء، بشيء من الدقة ملاحظاته وتمعنه في الأشياء والأحداث والناس والمدن وأمور صغيرة وكبيرة تتمكن ذاكرته من تسجيلها، يستخدم نفس كلمة التدوين بعد تسطير أسماء أصدقاء ومعارف ويوظف بدل ذكر اسمه: “(…) وأنا المدوِّن” فالتركيز على مصطلح التدوين ملازم أيضاً لفكرة الخوض في التاريخ؛ تاريخ الأشخاص والأشياء والأماكن، ولكن ضمن أحداث خاصة لها أهميتها، سواء لشخص الكاتب المدون، أو سواء للقارىء. ففي محل آخر من الكتاب يوظف (التدوين) هذه المرّة لمؤرخ كردي معروف، فيقول: “كان جليلي جليل الإيزدي، منهمكاً في تدوين تاريخ الكرد ‘الكشكول’، كل من كتب عن الكرد، من مصادر.”(ص150)
في نص خيالي نميز بين صوت الكاتب وصوت الراوي. في هذا النص، موضوع دراستنا، نص سردي لسيرة شاملة، يمكن القول، ذاتية وعامة في الآن نفسه. ذاتية، حيث الكاتب يأخذنا معه في جولاته وأسفاره ويجعلنا نشاركه قلقه، الفكري الوجودي بعمق وبظلال كثيفة من شجن مكبوت لأشخاص، لبلدان وحتى لأشياء صغيرة ينساها أحدنا في غمرة فوضى اليوميات، ودخلت في قيد غياب قسري، ربما الأفضل قول أَسْدَلت الذاكرة عليهم ستاراً كثيفاً، وكان يكفي سَفَر صغير، تغيير مكان لمكان آخر، حتى يطفوا على السطح: “لأملأ المكان بقلقي، هذه الظهيرة”.(ص60) أما لكونها عامة، لأنها تتضمن التكلم عن آراء وأفكار الآخرين ومواقفهم، وأحياناً أحلامهم وهفواتهم، وما رآه بالعين المجردة في كل مرحلة من مراحل تلك السنوات العشر. إذ يعبر عنها الحسيني بتعليقات دقيقة جمعها، حسب ما يقول في الغلاف الداخلي لبداية السيرة واستغرق كتابتهم “عشر سنوات” بين السويد وكردستان.
الكتاب من عنوانه “بهارات هندو – أوروبية”؛ البهارات تحمل نكهة، روائح، ألوان، وتتميز بطعم، ومنها تبتدع الطبخ بأطباق مختلفة. الكتاب مجزأ لفصول قصيرة وطويلة بحسب سرد وأهمية محتواه للكاتب، أحياناً رغم قصر بقائه في إحدى المدن لا تتعدى يومين أو ثلاثة كما هو حاله في مهرجان شعري، إلا أنه يملك ما يسرده. كل سطر يحمل بين طياته أسماء عرفهم الحسيني فيما مضى، منهم من رحلوا، منهم من كبروا في السن، منهم لا يزالون على ارتباط، منهم فقد الاتصال بهم، أو أخرون التقى بهم فيما بعد، أو لم تتعدَ لقاءات عابرة. أحياناً، رقم قصرها، حميمة، في منفاه العالمي. أقول عالمي، لما التمست من الكاتب في ترحاله المستمر بين الأمصار مقتدياً بابن بطوطة، إذ خص الكاتب فصلاً من السيرة بمدينة طنجة “في البحث عن إبن بطوطة”(ص463). أو كما سنرى لاحقاً، ربما البحث عن مثوى محمد شكري؟.
انطباع الحسيني عن مدينة (عامودا) يحتل مساحة شاسعة من الكتاب: “عامودا لم تعد مدينتي التي كانت. نزح منها أصدقائي. وتغيرت معالمها. البناء المدهش الجميل المرمر بلون سرقات الموظفين فيها.”(ص17) هذه اللحظة التي تبدو في نفس الوقت حرجة للكاتب، لأنه يقف على الفساد الإداري، نستشعر أيضا نغمة حزن صامت ككل مثقف لا يملك حيال انهيار القيم الا التعبير عنها بكتابة واضافة شعرية الكلمة المنتقاة بعناية على يأس داهمه: “بلون سرقات الموظفين…” أي لون يقصد الحسيني؟ حتماً اللون الذي يعكس في دواخل الفاسدين وتهكمهم. في مكان آخر نجد تعبير مميز عن (عامودا) : “(…) أنا بهويتي الضائعة: الكردي، السوري، حامل الجنسية السويدية، والذي يعيش دون نوستالجيا حقيقية لمكان يبتعد عنه، أو هو الذي ابتعد عن المكان: أعني عامودا.”(ص210) هذه اللحظات فيها الندم واليأس، وبعكس ما يظهره الحسيني، فيها حنين لا يطاق! لأنه يضع نقطتان (:) لشرح المغزى، وهي حالة الضياع التي يشعر بها، ككل من جرب حساسية ترك أرض ولد فيها وبنى له أسس الجزء الأهم من حياته وهي الطفولة. فالذاكرة تحمل شحنات ما مرّ به في الطفولة أكثر من أية حقبة حياتية أخرى.
سيرة شيقة، مكتوبة بسلاسة، بلبافة أدبية يعرف الحسيني إدارة تلابيب سردها. أحياناً نلاحظ فلت السرد الخاص بسيرة ذاتية، وندخل معه في أجواء شبه خيالية، بالأخص حين يتكلم عن الأنبياء والرسل والملاحم الكردية كملحمة “مم وزين” ونرى بأن أسلوب السرد نفسه، من خلال كتابة جمل قصيرة أشبه برباعيات شعرية، تأخذ انعطافة سريعة لتلتقي فيها السرد الأدبي الخيالي والواقعي مع أبيات شعرية: “كانت زين أمام المرآة نحيلة مثل شتلة زرقاء، نحيلة مثل الحنين، نحيلة مثل البقدونس في عرصة عامودا(…)”(ص61) الترديد خصوصية شعرية في الأبيات وهنا كلمة (نحيلة) تعاد مرارا للتأكيد على خاصية شخصية (زين).
الغربة وعمق الاحساس باالتشرد يتمثل أيضاً بصورة تشبيه الذات بشيء، أي تشيء النفس والجسد: “أكياس نايلون شريدة. هي مثلي…”(ص62) ربما التشرد الذهني أيضاً، ليس فقط التشرد كجسد بين عوالم غربية وشرقية، حيث لم يعد الشاعر والفرد المغترب يشعر بالانتماء الحقيقي لهنا أو هناك، بل يصير الانتماء واحداً وهو الانتماء للأرض والتربة فقط. نلاحظ هذا الخطاب الشعري عن المنفى في هذه الجمل أيضاً، حين يعيد قول الشاعر الفرنسي (؟): “راين… راين، يجري تحت جسورك حبي.”(ص153)، والملفت هنا أن الحسيني لم يذكر اسم الشاعر، ربما للتأكيد على أن ذاكرته لم تسعفه؟
ثم يقلب الموازين بأن يجعل من الراين المكان الأمثل الذي يشهد نفي الشاعر: “راين… راين…لا أحبك. أحب نهر عامودا المجفف.”(ص155) أو: “راين… ياراين، لا يجري حبي تحت جسورك. يجري منفاي تحت جسورك.”(ص157) وبالتالي المكان ليس إلا صورة مقتبسة عن المنفى الداخلي للشاعر الحسيني: “المنفى هو أن تتأمل ذاكرتك على جسور الراين. وفي متحف الراين.”(ص155) الذاكرة هنا تتحول إلى عامل مجسد، ويتم تأملها حين يتواجد الكاتب على جسر أو في متحف. ربما هي أيضاً لحظة مقارنة بين هنا وهناك، والتأسف على فقدان ما لدى الانسان الشرقي عموماً حين تتآكل كل أجزاء الذاكرة في هذه اللحظة الخصوصية، إلا أنها تنشط لتتأمل المفقود مقارنة بالحاضر .
ثم ليتبّل شيئاً من البهارات على عبثية الشعر، يقول: “ثلاث بطات، أراها كل يوم، تتهادى في الماء، مسالمة، هي البطات، فقط، لم تكن تهتم بالشعر في المهرجان.”(ص226) خصوصية المهرجانات هي الملل من البقاء جالساً للاستماع للأشعار، ربما السأم من العثور لمعنى الشعر حين يغدو العالم مليئاً بالعنف! لكن نلاحظ في موضع آخر، في نهاية الكتاب فصل معنون: “مَنْ منا يرتجف أكثر في المنفى؟”(ص475) يقارن بلوعة بين بطات تعيش في سلام في منفاه هو ولا يخفن، بينما الرعب والقتل نصيب الإنسان عموماً: “البطات، الميتة ذلك اليوم، أستدرجها إلى أن تفهمني: أجلس معها على العشب، وأغني لها بصوت مبحوح: “من منا يرتجف أكثر في المنفى؟” بطات اسكندنافيه، ترقد بطمأنينة على عشب صيف اسكندناف. ليست ميتة، ولا غائبة، ولا مذبوحة.”(ص477)
المدن بشوارعها وساحاتها ونافوراتها تتكلم عن نفسها من خلال هذا النص، وكل لها مكانه كبيرة، فيجسدها الشاعر وتصير بدورها كأشخاص مروا بحياته، أو يلتقيهم في لحظة كتابته لملاحظاته، فيحاورهم، يمنحهم الفرصة للتعبير عن أشكالهم، وحتى خصوصياتهم وتأثير الزمن عليهم: “على الحوض سفينة الفايكنغ، ومن هناك يتدفق الماء إلى الأسفل، ثم يرتفع مجدداً من ثقوب خمسة خارجة من رؤوس أسماك حجرية، كما ينزل الماء من أفواهها، ليركُد أخيراً في حوض الماء الدائري، حيث تطفو على سطح الماء علب البيرة الفارغة، مع زجاجة نبيذ أخضر عفني، أخضر الطحالب والزمن.”(ص73) الطحالب هنا تلازم زمن (مضى عليه دهر) لتعكس لنا التراكم الزمني المأسوي عند الحسيني. أو نصادفه يدخل في إحدى المدن ولا يترك بقعة بسلام خطى فيها إلا قام أيضاً بنبشها والتعرف في شوارعها والتلحف بأفكاره وخياله محاولاً تجاوز بردها وصقيعها. هذا الدخول المباغت للمدن والشوارع والمقاهي لم يكتبه الحسيني على شاكلة المفاجأة، كأنه يريد بهذا التقليل من أثرها وأهميتها. فما هو مهم له، المنفى ذاته كحد السيف القاطع للذكريات. المنفى يتحول لبقعة أرض يستعصي العيش فيها، ولهذا لا يسكن الكاتب في مكان واحد، بل يشرد نفسه بنفسه، ويختار المنافي الأخرى ليختبر العيش في كل منفى دفع بمفتاح بقائه فيه لفترة ما ثمن شبابه، ولكن بالخروج منه بسرد يكشف عالمه وخواصه.
البلدان عند الحسيني كل منها لها شكل مميز كالواقع الذي ينتقيه لنا من خلال جولاته في أرجاء المعمورة، فيصور نفسه رحالة يعرف فنون السفر والضيافة، ولكن أيضاً المخاطر الجسدية والنفسية والروحية والفكرية. حيث يصير الكاتب مواجهاً لذاته أكثر مما هو مواجه لنا. البلدان عنده تأخذ حقها لتكون دائرية الشكل كالكرة الأرضية نفسها، كما ابن بطوطة، فندور معه ببطء على محور سرد يتقنه وعلى جرعات حددها بحسب التفاصيل. الصفحات التي يخصصها لمدينته (عامودا) صفحات تدخل في تدوين الآلام التي يشاطرها الشاعر بشعرية تفوق الأجزاء الأخرى من الكتاب، ليركز على أهمية الحدث المنتهي اللامنتهي في ذكرياته عنها. سواء بسبب موت من كانوا هناك، أو بسبب الفراغ الملموس بعد العودة المنحشرة بألم فقد معالم الحاضر: “عامودا ليست مدينة، هي اشارات شفاعات من الله لأبنائها القتلى في سينما عاموادا”(ص 117) هذه الاشارات تنويه لتخيل الحسيني للموجودين في المكان لحظة الحادث. وتكرار اسم عامودا على طول السرد، محاولة لترسيخ اسمها أيضاً في ذاكرة الآخرين. أهو خوف من النسيان؟ من نسيان مدينة الأم، حيث ترك أحضانها لأحضان الأمهات الشقراوات في البلدان الغربية؟.
يعود بنا الحسيني لأحضان الأم وهي نفس أحضان الوطن؟ لأن الكاتب هنا يحملنا معه على ظهر سفينة لأرض السويد ويعتبرها الأم الشقراء. صيغة الجمع هنا تعود لانتقاله المستمر بين بلدان اسكندنافية وغربية. من هنا أيضاً تبدأ رحلاته في اللاستقرار وعدم وجود سقف يأويه حقيقة، إذا نظرنا للمفى بمنظاره، لكنه يبقى متشبثاً بتلابيب الشعر: “كانت السفينةُ العملاقةُ تستقرُّ في السويد، وفي اليوم التالي، كان أحمد حسيني معنا في السويد. لقد انزلقنا مرة ثانية من أمهاتنا المكدودات، إلى أمهاتنا الشقراوات ـ السويد هذه المرة. وستبدأ رحلةٌ، هي رحلة الوصول إلى أن تكونَ منفياً، وتكتب الشعرَ في المنفى.”(ص202)
والقراءة السابقة للمنفي الحسيني، هي تجسد المنفى في كل المصطلحات التوظيفية في النص. فالتساؤل إن كانت تلك المدينة التي تواجد فيها هي حقاً مدينته حينما يتكلم عنها للآخرين، أو عندما يقترح لأحد معارفه بالمجيء إليها: “كان يزورني، ثم انتقل أيضاً إلى مدينتي ـ هل كانت مدينتي؟”(ص202)
حالة الحسيني الشاعر المنفي، يراه بوجهين مكتملين للموت، يدعوه للتساؤل، وليس وراء تساؤله إلا تلاحم الشعر والمنفى كمكمل الموت، وهذه الأخيرة كوجه دقيق للسيرة: “أيةُ سيرة، أسردها؟.”و: “أسيرة الموت، أم المنفى، أم الشعر؟”(ص205)
نلاحظ أيضاً المقارنة الجغرافية للوصول إلى مغزاه. حيث التكلم عن مكان أقام فيه، وإن كان قصيراً، لابد أن يأخذه إلى صلة وصل بجذوره. حيث يواجه مدن الغرب بتلك الخاصة بالكرد، رغم تشابهها تبقى الخصوصية لصالح المدن المأهولة بالكرد والمعروفة بحماوة العيش والضيافة فيها ومجالس المقاهي. الظاهر أن الشاعر يفتقد فيه التكلم وتبادل مناقشة حتى لو تجردت من معنى. إذ هي حاجة انسان لانسان يبادله الحوار: “لوديف تشبه ديار بكر؛ هي مدينة مصغرة عن دياربكر، لكن ليس فيها أكراد. تمتليء لوديف بالمقاهي مثل دياربكر؛ تمتليء لوديف بالحجر القديم، مثل حجر دياربكر، ليس في لوديف قلعة دياربكر، وليس في دياربكر نبيذ لوديف، المقاهي هي عصب المدينة الصغيرة.”(ص224-225)
نستنتج من تواجد الشاعر في مكان مهرجان مثل مدينة (لوديف) الفرنسية، فرصة يقتنصها تارة للإشادة والانبهار، وتارة نوع من تهكم مضمر من خلال المقارنة التي سمة من سمات هذا الكتاب، حين يأتي على ذكر العاهرات والثكنات العسكرية والتواجد الفرنسي. فيذكر المطبوعات الشعرية وأسماء شعراء كلاسيك، ويذكرهم بترتيب ملفت، ربما تعود لخصوصية أحدهم عن أخر. فالشاعر (رامبو) في المقدمة: “(…) رامبو، لوتريامون، بودلير، ت. إس. اليوت. شعراء القرن الذي ينتمي إليه البانسيون: القرن الثامن عشر والتاسع عشر، حيث تسهب صاحبة البانسيون في مدح ظلال وأنفاس العاهرات اللواتي عشن قبل أكثر من مئة عام، بجانب الثكنة العسكرية الهائلة. حيث تنتعش التجارة البيضاء، مع العسكر؛ في عامودا، في الزمن الذي كان فيه الفرنسيون، بنوا ثكنتهم “القِجْلة”، وبنوا أيضاً بيتاً للدعارة؛ بيت طيني، صغير، ربما أربع غرف وصالون، وشجرة توت ضخمة؛ البيت الطيني، كان قريباً من الثكنة، حيث العسكر، كانت عامودا، في الثلاثينيات، تموج بالشعر، كانت عامودا تشبه لوديف.”(ص217-218)
جغرافية أخرى تدعو للتكلم عنها مرتبطة بالحدث وليس بالمكان. فالحسيني يرغب بسرد ومزج ذاته بالبحر. والبحر هنا مساحة لامرئية خطيرة، يغرف منها الشاعر أبياته، ولكن لا ينسى غدرها. فهنا يعود بنا إلى ماضٍ لا يختلف في المبدأ عن ماضيه، الحروب السابقة، والحرب بشكل عام ما نتقن التكلم عنها جميعاً، نحن ساكني الشرق، وفي هذا العصر الدامي المليء بأحداث وكوارث بشرية خطيرة، فلا يمكن عبور أوغوص البحر بسلام: “تمتد مونبيلييه على البحر الأبيض المتوسط، هو بحر أنتمي إليه أيضاً؛ بحر خاض حروباً كثيرة، وخاض قهراً أكثر، غرقتْ فيه سفن كثيرة، وغطس فيه مغامرون كثيرون، وعلى مائه أبحرت سفن كثيرة تحمل مهاجرين بؤساء من الكرد والأفارقة والأفغان…”(ص211)
من مضمون الجمل يصل الشجن بالشاعر للقمة. فالتكلم عن “القضية” وهذه الكلمة تحمل عدة معانٍ، ولكن المغزى يبقى مكشوفاً، حين يتساءل الحسيني الكردي عن هويته ككردي يكتب بالعربية. التساؤل بين الهوية واللغة يحسمها بجواب الكتابة بالعربية ولم يفقد شيئاً من انتمائه. لكن قبل كل شيء هو انسان، كاتب شاعر ينتمي لهوية واحدة هي الانسانية. وهنا بالتحديد تنقلب مسألة القضية الآنفة لتتحول لقضية انسانية شاملة: “أتساءل بيني وبين نفسي: “ماهي قضيتي؟”، وأنا أعرج من أفريز البيت الروحاني، إلى روح الشعراء في المدينة. قضيتي أن أكتب نصاً قوياً، تدل على هويتي الكردية، بالعربية.”(ص217)
السيرة الذاتية وسيرة الأماكن والناس المحيطين بالحسيني، تتطلب الغوص في الذاكرة أيضاً. فليس شرط أن يتذكر كل ما مرّ به طوال حياته، لا في موطن ولادته، ولا كل تلك المدن: “وفي استدعاء الذاكرة. استدعاء ما لايأتي.”(ص161) ونعرف جميعاً أن الذاكرة رغم اختيارها للحظات الحنين: “في لوديف، قرأت شعراً حنيناً لـ عامودا…”(ص221)، ستبقى انتقائية، إذ التذكر يتم بخطوط عريضة أفقية وليست هرمية، تشمل كل ما رآه و اختبره وشعر به، أو يود بكل بساطة نقل انطباعه، من أحداث و بشر وبالأخص الأحداث الرهيبة التي تترك آثاراً جانبية لا تلتئم: “المكان الأول، هو ليس بشعر، بل قهر، وأعني عامودا.”(ص225) في موضع من بداية الكتاب نلاحظ أن الحنين ملازم للكآبة وخصوصية البرونز، وهذه الأخيرة تتكرر مراراً في النص، والحسيني وظف البرونز الراكد، أي الذي لا يتحرك، فصفة الثبات المعدني تضيف قوة على عدم زحزحة الكآبة والحنين: “لازلتُ أحب البرونز وروح البرونز الراكدة في خيالي. مشاريعي الآن، هي الكآبة: في هذه اللحظة أشتاق إلى عامودا.”(ص18)
لكن عندما يصل الحسيني إلى تدوين بعض الأسماء، الذاكرة تتحول لنقطة ميتة ولا يتذكر اسم ما. وهنا نقع على صدفة جميلة في النص حيث نفس تلك النقطة الميتة يعطي السيرة حيوية شعرية غريبة تشعرنا بصدق ما سرده في الصفحات السابقة ولكن اللاحقة أيضاً: “(…) نبدد نصفها في شراء الشامبوات من محل السرياني، من يتذكر اسمه؟ ليكن “سريان”(ص221) في مكان آخر لأهمية هذه النقطة عنده حتى وهو لا يتذكره يسجله وأحياناً يعطيه عنواناً فرعياً لفقرة مهمة: “الأعمى الذي لا أعرف ما اسمه”(ص93)
إعادة بعض الاحداث من خلال اختيار مقاطع أو جمل، ليس إلا إصرار على أهميتهم وما ترك فيه من أثر: مات “كسرى عفدي” ونكبة حرائق عامودا وحريق سينما شهرزاد في عامودا وذكر اسم (أحمد كايا) المطرب وموته وموت السينمائي (يلمازگوینای) في ريعان شبابهما… صفحات نلتمس منها أيضاً نقد السياسة من الساسة والأنظمة من سجون سوريا: “(…) هي وأختها مزكين يعدان نجوم الظهر في أقبية دون نجوم. في أي سجن هما؟”(ص235)، إلى نتائج السياسة في دول أخرى: “في بولونيا، تعرفنا على الغجر هناك، الغجر الذين نشَّفت الشيوعية أرواحهم المتمردة، ورمت بنسائهم الجميلات السمراوات، أمام أبواب الفنادق، للتسول والعهر.”(202)، لكن عندما يصل الأمر بذاكرة المكان الزائل، الممسوح، المهمش، تتحول كل مراجعة لها لجرح تشعل حرائق في ذاكرة الكرد والأكثر حرقاً تبقى بلون وحرارة الحريق نفسه: “كان السيد محمد طلب هلال، منهمكاً في ذلك اليوم ‘الأسودين’ في إشعال حرائق ذاكرة الكرد: 1ـ حريق سينما عامودا. 2 ـ حريق سجلات المواطنين الكرد، وتبديلها بتسمية لا مثيل لها في سجلات الكرة الأرضية والسماوية العظمى بناءً على اقتراح السيد نفسه…”(ص175)
النفي لا يتوقف عند الحسيني وأصدقائه وأهله وأعزائه، بل يمتد ليتكلم بشيء من تاريخية للعودة إلى أسلاف السويديين: “كانتِ القوافلُ السويدية البحرية تهاجر إلى أمريكا بكثافة الفقر والهجران بداية القرن العشرين، في حين كان النحاتون يستعيدون مجد الزمن البرونزي في قوالبهم النارية، يخمّنون مقاسات الأجساد الرشيقة (…)”(ص252)، ربما رغب الكاتب المنفي ذاته في هذه اللمحة السريعة بجلب اهتمام القاريء لتاريخ الهجرة والنفي داخل نفي أكبر.
بعد النفي، يجعلنا الحسيني نخوض في عالم التوابل والبهارات. كأن به يحضر الطبخة في البدء، ثم يضيف لها النكهة المعدة مسبقاً. فيخصص الفصل الذي عنون الكتاب أيضاً بعنوان “بهارات هندو- أوروبية”(ص273-282). الفلفل الأحمر الحارق مرتبط بمدينة ديار بكر ونوروز. السماق المعروف بطعمه الحامض يحمل نوروز تلك الفترات طعمها. النعناع الجاف يشبهه بالموت في عامودا. الكمون يأخذنا إلى عملية اخصاء الأكباش ويوضع على جروحهم… تفاصيل سياسية واجتماعية وذكريات أخرى ممزوجة بكل هذا، حتى يختم الفصل بيأس مجسد في صورة توابل/ طيور منسية وهذه تتجسد في حكاية المنفي: “التوابل، هي الطيور. والطيور هي الرفرفة العمياء لحكاية المنفي. وهي بهارات منسية في مطبخ منسي على أرض منسية تحت سماء منسية.”(ص282)
في الفصل اللاحق يشبه بين المؤرخ (شرف خان البدليسي) مع المؤرخ المعاصر والمدون خيالاً للوجع الكردي من خلال رواياته وأشعاره (سليم بركات)(ص287) وهنا الحسيني ينعته بمدون الموت في كل كتاباته. لكن الموت عند بركات ليس إلا للتكلم عن أهمية الحياة نفسها: “سليم في كل كتاباته: يدون الموت، هكذا أرى. حيلة. طهو الحياة تدوينا.”(ص289)
الذاكرة عندما تفقد دقة الوصف يحث المتذكر للجوء إلى حيوية الوصف الآني المرتجل، إن أمكنني قول هذا. أي ما يدعو الشخص لتذكر لحظتها حين يشرع بالتكلم أو الكتابة. فيجد نفسه يقول ما لا كان يخطر بباله ولم يحسب حساب أنه سيتذكر بدقة: “هل سأتذكر ما حدث في قامشلوكي؟ فلأتذكر: الطريق الذي يمرّ من بيت جكرخوين. إلى مركز المدينة، يمر عبر الكالحة…” (ص299) ويستمر إلى نهاية الفقرة بوصف ما شك في نسيانه. لكن عندما يتعلق الأمر بغيابه عن المكان، يغدو حاسماً ومصراً على عدم تذكره: “هل سأتذكر؟ لن أتذكر. لأنني لم أكن هناك.”(ص300)
الضوضاء كأي صوت أو رائحة أو عطر أو طعم… يثير ذاكرة السارد. فمع ضوضاء الجرارات (الكاتربيلار) تُرفَعْ الغطاء عما سبق. سواء في قامشلي أو في ستوكهولم أو في أي مكان أخر. الوجه المضاد لذلك الضوضاء صوت رقة الموسيقى المنبعثة من الكمنجات. الجرارات هنا تصير شاهدة على ما حدث، فيجسد الحسيني في تلك الآلات شجن مكتوم، كأنها بشر يشهدون مشاهد قتلى لا حصر لهم في عوالمنا الشرقية عموماً: “هل كان على الجرارات الكاتربيلار، أن تشهد ما شهدت؟”(ص301)، التساؤل هنا ليس إلا للالحاح على سؤال: هل الجرارات مجبرة على أن تشهد ما نشاهده نحن البشر من فظائع؟
الكتاب لا يخص التوابل فقط، بل الأعشاب والزهور والثمار أيضاً. ففي هذا الفصل يبدأ قبل كل وصف باشارة فيها تهكم لاذع ومرارة مضغ عشب جلجامش الذي لم يمنحه الأبدية، ولكن المعرفة نعم. حيث يصف الحسيني قشطة الجاموس بهذه الجمل: “نبتةُ جلجامش، التي لم يصل إليها، غير جلجامش، فمضغها؛ ثم من مرارتها، لفظها؛ نبتة كلكامش التي يبحث عنها القادة السياسيون في العالم الثالث، ويبحث عنها الجاموس في مستنقعات القامشلي، الجواميس التي تجترُّ نبتة المستقعات القريبة من ‘حِلْكو’، وتراقب قطار قامشلي ـ حلب، وهي تحمل المخابرات، والمساجين الكرد، الذي يأكلون قشدة نفس الجواميس…”(ص325)
بعد العشب المرّ كبداية ليستهل به الدخول إلى وصف وربط النباتات والثمار الأخرى، يأتي على ذكرهم ويتعلقون بلحظات انسانية معينة في حياته. فالتين هي الغياب التام لطعمه منذ دخوله أو وجوده في المنفى. إذ لم يتذوق التين لسنوات طويلة: “منذ خمسة عشر عاماً، لم أرَ شجر تين، ولم اذق التين، إلا في مرات نادرة يبيعه السويديون وكأنه تفاحة آدم في الجنة…”(ص326)
(زهر العندكو) يأخذه إلى عطر القرى ونسائها وحقولها، لكن تمحى تلك الصور الجميلة مع مجيء الطائرات: “في حقول العندكو التي جاءت الطائرات الزراعية البعثية (الاصلاح الزراعي) فرشّت على تلك الحقول سموم الشمولية، فذبحت الحقول والزهرة والأنوثة ونحن، أولئك المبتدئون بالكتابة ومراقبة النبات.”(ص327)
(زهرة الحب) تتعلق بطقوس الايزيديين التي يخصها الحسيني بصفحتين. ثم يأتي على ذكر نباتات وأشجار أخرى، مثل شجرة الديمقراط ويصفها أيضاً بشكل تهكمي بـ: “شجرة جففها العالم الثالث.”(ص335)
في الفصل القادم “برجُ كنيسةِ السريان القديمة، في عامودا” ندخل مع الحسيني إلى عالم السريان. يشحذ ذاكرة القارئ بإعطاء تفصيل عن وجودهم في عامودا ونزوحهم من تركيا بعد اضطهادهم. وجملة واحدة كأنها تفلت من ذاكرة الكتاب وهو يتساءل: ” لكنْ، لماذا هويتُ من أعلى برج كنيسة السريان في عامودا، ذلك الفجر الأخضر!؟”(ص341)، التساؤل ليس إلا من ذاكرة شخص كبير عن حادث في صغره، ولا يتذكر بالضبط السبب، ومع ذلك يفضل ذكره. لأنه بكل بساطة يسرد كل ما يهمه ألا يفلت منه زمامه حتى لو جهله. لكن بعد صفحات يختم الفصل قائلا: “لم أسقطْ من أي برج. بل هي أوراق الخريف تسقط، فترنُّ من مريمها الأم الشجرة، على الأرضِ الاسكندناف.”(ص343)
هل تذكر الحسيني ما حدث بعد أن دوّنَ ما قاله سابقاً؟ أم يعمل شبه مقارنة واستعارة لغوية بين سقوطه الحقيقي وسقوط ورقة من شجرة؟
عندما يتكلم الحسيني عن المطابع والكتابة ينغمس في التشييد باللغة العربية والعطب الذي يصيبه حين تكون الطبعة جميلة والأخطاء على شاكلة الفساد الإداري والسياسي التي لا تحصى: “لم أسأل عن الركاكة في الصياغة اللغوية الإملائية الطباعية، في الكتاب الكاتالوغ الناجح الأنيق، والفاسد لغوياً عربياً. بل سألتُ عن المكان. الروح الشاعرية للمكان.”(ص363)، المكان يتعلق بدرجة كبيرة بما هو محمول في الذاكرة. فروح المكان هنا ليست إلا جمالية شعرية لما يراه وربما تخيله الكاتب مسبقاً، وثم كبر في مخيلته صورته الشعرية ليسجلها فيما بعد حين التمس ركاكة اللغة بالمقارنة بجمال المكان. المكان اثارة عزاء أيضاً. فحين يجوس في شوارع كردستان يتذكر جدته، لكنه يشتاق لشخصه القديم. إذ يرى ذاته غائباً عنه. هذا الغياب ولّده المنفى المزمن، ولا يسعه العودة للمكان المرغوب مرة أخرى للعيش فيه. لأن الزمن القديم تمحل أيضاً الشخص الذي كان وليس هو فقط، بل كل أقاربه الأموات وأصدقاءه الأموات والأحياء المشتتون في المنافي: “أخرجُ من حرارة الساعة العاشرة والنصف من المتحف، إلى حرارة شوارع كردستان، كنتُ أدخن، كنت وحيداً، كنتُ أتمنى أن تكون معي جدتي سلطي، صانعة فخار عامودا، لمدة خمسين سنة، كنت أتمنى أن يكون معي: جدتي سلطي المتوفاة من عهد قريب. كنت أتمنى أن يكون معي محمد عفيف الحسيني، القديم.”(ص362)، ثم يأتي الحسيني على ذكر الصلصال. هنا الصلصال يصير، من جهة الوجه الآخر للكتابة والتدوين، من جهة أخرى الوجه المكمل للكتابة، وهو الانسان. فحسب الدين خلق من صلصال. وفي كلتا الحالتين يتعلق الأمر بالخلق والابداع (الكتابة/الانسان) وكل كاتب في نفسه ينقب عن المبدع فيه: “الصلصالُ، هو هبة الله، هو ممكنات الله، على أرض الله.”(ص363)، ثم في فصل “شهقة القرميد” يصير القرميد أيضاً وجه من أوجه الصلصال المتذكر: “هو طينٌ مشويٌّ. استخدمه الأقدمون الأسطوريون في معابدهم، وفي بيوتاتهم الأسطورية. طوبٌ أحمرُ بعضه، مشوبٌ بالخمريِّ، وبعضه أصفرُ، مشوبٌ بتلوِّنٍ أصفري. القرميد، بلونيه، يسودُّ مع تقادم الزمنِ والحروبِ والشمولِ. لكنه، على الدوامِ، هو صلبٌ، قاسٍ، عازلُ، وجميلٌ (…) أراقب قرميد أوربا، فأتذكر قرميدَ الشمولِ. قرميدٌ قرميدٌ قرميدٌ. قطعةٌ قطعةٌ قطعةٌ…”(ص383-385)
لاحقاً يواجه الشاعر الشوارع ببعضها من: “هو الشارع من نُزلة هليلكي، إلى الحارة الغربية في قامشلي.” (ص399) ويدون ما مضى من أحداث مرّ به آخرون في زمن أقدم. فيصفف أسماء عديدة، تاريخية، عربية، مروا من هناك، مستعيناً بالذاكرة حتى عندما يدون ما قاله أحدهم بالخطأ، وهو يذكر اسم دولة المغرب بأن الرئيس جمال عبد الناصر ينتمي إليها: “يمر الكرد، العرب، الآشوريون، الكلدان، السريان، الأرمن، الجاجانيون، الملائكة، جبرائيل وعزرائيل، وملكا الموت، والبراق العجيب، وتمر نفرتيتي، في رحلتها من واشو كاني، إلى لعنة الفراعنة (…) ومر جمال عبدالناصر، رئيس المغرب، كما قال ‘صلاحي’…”(ص398) هذا الشارع الصاخب بأحداث سياسية، عسكرية، بؤس العيش والتدمير، يقابله الحسيني بشارع آخر في منفاه السويدي. يصف خصوصية هذا الشارع أيضاً. من معالمه، بمرور الباصات عليه، إلى حشود المشاة، جمهرة المتظاهرين، إلى مواعيد العشاق في مقاهٍ وُجدت في نفس الشارع. لكن رغم كل الصخب هنا الطمأنينة التي لا تختص بها شوارع قامشلي وعامودا وغيرها من مدن تسود فيها الحروب والدمار: “من ساحة Järntorget، إلى كنيسةHagakyrkan ، ثمت معابر ثلاثة: الشارع الرئيس المنتهك بالترامات والباصات والسيارات والدراجات والمشاة مع كلابهم وسيارات الاسعاف المرعبة وسيارات البوليس غير المرعبة، وأحياناً مركبات الاطفائية(…)ومواعيد بضعة عشاق قلقين في ساحة المقهى، ثم في الولوج إلى المقهى الدافىء الحار، العابق برائحة الطمأنينة والسيكار.” (ص401-404)
ثم يأخذنا لشارع آخر يحمل مرة أخرى ذاكرة مكان مدميّ: ” الشارع الثالث، يقع في عامودا، وليس في السويد. يمر عبر كنيسة الأرمن القديمة المبنية من الطوب غير المشوي، وسينما عامودا الأولى، التي انطفأت، قبل حريق الثانية الشهرزادية…”(ص405)
كما يخصص الحسيني فصلاً عن الأسلحة. وكيف لا يخصص كردي، أو شرق أوسطي أو أي أمم أخرى تعاني عموماً، كل تلك الأسلحة التي تنفذ مسرعاً من كثرة استهلاكها كأية بضاعة أخرى: الرصاص، الدبابات، العصي الكهربائية، الغاز المسيل للدموع… التكلم عن السلاح يرافقه الدم والصخب والشجن. ودوي الرصاص ليس كرنين أجراس الكنائس: “ياريت وياريت يكون السلاح الرنينَ.”(ص430)
كما يخصص الحسيني فصلا عن الأسلحة، يخصص أيضاً فصلا عن الكانئس والجوامع في سوريا وفي السويد، لأهميتها في حياة الناس تاريخياً وروحياً. ثم شعريّ في سرد نوعية ولادته الرمزية وأشعار مقطعة مطعمة ببذور الريحان، ووصف يعود بنا من رحلته من كردستان إلى غوتنبورغ و”قصيدة حب بسيطة، عن الحيوانات والحرير” العنوان نفسه لا يحتاج منا فك شفراته. ثم ينهمك بالبحث عن الرائع، قتيل البؤس وكاشف الحقائق (محمد شكري) وهو حي في مثواه الأخير في طنجة.
في فصل “من يرتجف أكثر في المنفى”(ص475) يقوم بذكر ملوك السويد ويقارن بهم ملوك كرد لا يؤتى على ذكرهم وطمست أثارهم، ومن بينهم من أسس مدناً وعمّرها. هذه الفصول الاخيرة كأنه تذكير بدمار داخل دمار وقهر داخل قهر. قهر سوري للشعب عموماً وفخ القومية التي تمحي هوية الآخر وإن كان تاريخياً: “الذي بنى عامودا، كان ملكاً. الملك أوركيش، بمنقاره النحيف. الذي بنى كفر جنه ـ سەري كانيي، قبل تعريبها، كان ملكاً، الملك هوري، أو النبي هوري، بمنقاره الأخضر، الذي يشبه الزيتون.”(ص480) وفي فصل “بهارات كردية”(ص483)، يعزز الحسيني هذا القهر القومي بالاشارة إلى حال النشر والطبع والترجمات من الثقافة الكردية إلى الثقافة العربية والاجحاف الذي يلاقيها: ” الثقافة الكردية، ثقافة مقهورة، مثلها مثل كردستان، في جهاتها الأربع؛ أين الترجمات لهذه الثقافة من الجيران، ومن غير الجيران، لهذه الثقافة الزاخرة الهائلة التي أكلتها نيران التقاسيم واللهجات والعذاب الأبدي؟”(ص492) ، ثم يتوقف حول تساؤلات عديدة، علنية، مضمرة المعنى، حول الكتابة باللغة العربية من قبل كردي: “خزائن الكرد الابداع، لازالت ترقد بين منظومات اللغات ـ الجوار؛ هنا يمكن الحديث عن تجليات هذه الثقافة التي أقصتها دول الجوار، يمكن الاشارة إلى العنف الثقافي الجار، نحو الثقافة الكردية الجيران؛ الثقافة، التي طالما دفعت ضرائب مدوَّنة على خيال أرواحهم.(…) الضريبة الأساس، لماذا لاأكتب بالكردية، لماذا لايكتب سليم بركات بالكردية، لماذا لايكتب ياشار كمال بالكردية، لماذا لايكتب علي أشرف درويشيان بالكردية؟ هي أختام أسئلة، هي نحن ـ المكدودين المنكوبين بمفاتيح لغات غير لغاتنا، أجدناها، وبمثاقيلها كتبنا. لماذا لانجد أبداً، كاتباً من الجيران، يكتب بالكردية؟. لماذا لايتحدث جاري معي بلغتي، كما أتحدث بلغته؟.”(ص494)
يختم الكاتب جولاته وطبخه المتبل: “في فتنة السفر، أتذكر دائماً، بأنني سأموت هذه المرة؛ وفي كل سفر، أكون طائشاً، لاأسأل عن الموت، أغامر وآخذ رحيق السفر أينما كان؛ ثمت روح طائشة ومغامرة تسكنني، هي روح أجدادي قبل الميلاد ربما، بأربعمئة سنة، روح زينفون الإغريقي، وهو يعبر أرضي، فيتصدى له أجدادي بفتنة النيران وفتنة الجبل ورعونة الرشاقة الجسدية؛ رشاقة وعولهم، هو أنا ذا الطائش في السفر، ومع ذلك، الطيش الغني بالحيطة والحذر، لكن، سلوان السفر ينسيني أنني سأموت هذه المرة، أو سأُقتل.”(ص509)
هنا يخوض الحسيني في سيرة موت الشاعر السارد، هو، حيث الخوف والقلق الوجودي المشروع حين تقرب السنوات عمرنا نحو أبواب الموت ،ولا زال هناك الكثير مما لم نكمله، وما لا تكلمنا فيه، وما لا نعرف حتى إن كان ستتواجد لهم حلول صحيحة أو يطمسون إلى الأبد؟ هذا القلق يأخذ بعداً أكثر رسوخاً حين نسافر. فالسفر والترحال الدائم ليسا بأمر عادي، بل يعّجان بمخاطر، ليس فقط على مستوى جسدي، بل على مستوى عقلي وادراك معنى (ما قبل وبعد السفر) ولما نصير إليه. هل يبقى أحدنا نفس ذاك الشخص الذي كان قبل الشروع بالسفر؟ هل نتحول إلى انسان آخر شرس وعنيف بسبب بعض أحداث؟ أم نصير أكثر تفهماً وتسامحاً؟
يختم محمد عفيف الحسيني هذه السيرة: “سفراً طويلاً، قطعته في هذا الكتاب، لتكن الخاتمة.”(ص513)
إنها خاتمة هذا الكتاب وليست نهاية سيرة. فالأسفار قادمة وستكتب..
باريس
محمد عفيف الحسيني “بهارات هندو- أوربية” سيرة ذاتية، دار نشر هنَّ، القاهرة، 2020