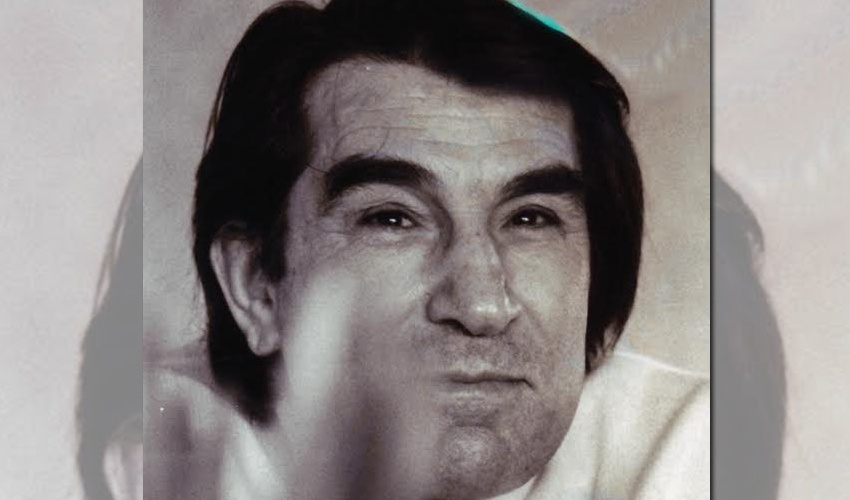ترنيمة البدء ..
” آه مما عرفت ، ومما تعرفت عليه “
– نيرودا –
لا أدري لم تحضرني الفقرة الأخيرة من الحوار الآسي في مسرحية هاملت وبالذات مشهد المقبرة الشهير ؟!.. وأنا أتسلل عبر دروب ذاكرة موغلة في تفاصيل الزمان والمكان / وبقايا صور/ تكاد تهرب مني كما غابت بغياب الشخوص الذين رحلوا…يقول المشهد الشكسبيري :
اصعدْ فوق أكوام الخرائب وتمشَّ هناك وانظر لجماجم الأعلين والأدنين..من كان الظالم منهم ومن المظلوم ؟ من الشرير أوالخيّر؟ إنهم جميعاً منسيون ..في مدن منسية ، وستصبح بعد أجل يطول أو يقصر واحداً منهم فلماذا تعذّب نفسك وتعذبني معك ؟ ! باللهاث وراء لذات لن تعقِب غير الألم والندم بل لن تنتهي – ونحن معه – إلا إلى التراب ..
انتهى حوار المشهد وترتيلة الوجود والموت .
قيل في البدء كانت الكلمة.. وعندنا في هذه الجغرافيا كان الماء والتراب وأناشيد الخصب والسفر مع الجداول الجامحة حيناً والهادئة أكثر الأحايين…. ليس للبدء بدء ولا للختام ختام … هنا في المسماة “كوباني” تتداخل الأقدار والمصائر والأزمنة والولادات والأعمار والقرى المتناثرة كابتهالات العجائز في قسوة شتاءات الشمال و أغبرة الصيف اللافحة.
في سهل سروج « دشتى سروجه » تلك البقعة المنسية والمنقسمة بقوة السياسات الغاشمة لا بقوة مراسيم الجغرافية الإلهية .
وهنا لا أريد أن يتحول النشيد الجميل لطفولتي وصباي إلى لحن جنائزي وأنا أدوّن سورة ” كوباني ” في يباس خريف العمر.
في المخاض والولادة ” قطار الشرق السريع”
ليس للمدن في هذا العالم شهادات ميلاد واضحة وقلما تربط الولادة بتواريخ في تيه هذا الشرق ، وحدها ” كوباني” كانت على موعد مع الزمن ، فتحت عينيها – كما يقال – على إيقاع طبول الحرب الأولى حيث الدول الضارية بسياساتها الكونية الكاسحة تشحذ أنيابها , في فورة الدم القادم مع الحرب .
فرنسا والإمبراطورية العجوز إنكلترة و روسيا الباحثة عن هويتها الأوراسية وألمانيا المزهوة بسيف « سيجفريد » الفولاذي والبقية الباقية من الإمبراطورية العثمانية التي تحاول إبدال أسنانها المنخورة بطقم أوربي حديث ، هذه الدولة التي انهارت أسوارها عن سجن كبير للشعوب المتطلعة إلى حقها في الوجود ومن وراء ظهر الشعوب كانت اتفاقيات أبرمت ونمت كالفطر السام في عتمة زمن يجيء ، فكانت المذابح و الإبادة والتهجير و زرع عداوات تاريخية بين الشعوب.. هي مفردات تلك السياسات المقيتة .
كان يوسف باشا التركي وفرانكلين الفرنسي يرسمان على الورق خطوط وقائع جديدة.. وخرائط جديدة..”فكان ما سوف يكون”!؟ أذكر.. في السنين الطاعنة في الطفولة والحنين ؛ كان صفير قطار الشرق السريع المبحوح يخترق هدوء ليل « كوباني» كئيباً موحشا يثير فيَ خيالات ترحل في فضاءات الطفولة المطعونة بالخوف واليأس .
كان الصفير يتداخل ونباح الكلاب الشاردة ونقيق الضفادع المنبعث من البحيرة المستلقية على حدود الخصب والحور والدلب وأصيافنا القائظة والبط المهاجر إليها من بعيد من جغرافيات تقع في حدود الظن ، كنت أتخيل نفسي هناك قريباً من ذلك القطار الأسطوري الأسود ذي العجلات الكثيرة والحافلات الصدئة ؛ في المقدمة منها تتموضع حافلات للركاب تسمى « الإكسبريس»
أتخيل نفسي هناك على تلك الأرصفة الكئيبة ألوح لأولئك المسافرين إلى البعيد.. ربما إلى لقاء الأهل والأرض المنتظرة لمواعيد قد لا تأتي .. و لربما إلى غربة لاعودة منها…
هذا القطار العتيق كان يسيرعلى الفحم والبخار كقطارات تلك الأزمنة ، كنا صغاراً نعدو للفرجة عليه ومشاهدة طقوس تحركاته ومراقبة الرجال ذوي السحنات القاتمة البائسة ، العمال كانوا يبدون مثل عصافير خرجت من مداخن مدافىء شتاءاتنا الحميمة .
ينطلق القطار هادراً يعلن عن نفسه.. كان يبتعد ملوحاً بسحابة دخان أسود ويبدو مثل ثعبان يتلوى عبر سهل سروج ومن ورائه آهات ومناديل ملوحة بليلة ورغبة طفولية في اللحاق به .
بين القطار و«كوباني» حبل سري نشأ في لحظة تاريخية نادرة كأنما هي لحظة قدر تراجيدية مثل تراجيديات الإغريق.
الألمان كانوا في عجلة من أمرهم استعداداً للحرب وإلى جانبهم الأتراك الباحثون عن مكان لهم تحت الشمس بعد أن دالت دولتهم العليّة وانتهت إلى رجل مريض يتعجلون موته.
ومن أجل الحرب شقت الشركة الألمانية المسماة «ب – ب – ب» وهي الحروف الثلاثة الأولى من شركة « برلين – بغداد – البصرة » وكلمة company»» تعني «الشركة» و ربما جاء الاسم من كلمة
« كمب» وتعني المخيم أو المعسكر هذا كل شيء عن سحر هذا الاسم « كوباني» ولا شيء آخر.
ومرة أخرى كان فولاذ مصانع « كروب» الألمانية حاضراً نهماً ليمارس لعبة الموت القادم ، إنها الحرب إذاً ، حرب الضواري … حرب الآخرين عندنا .
العمل في السكة بدأ عام 1912 وامتدت كالسيف في رحاب هذه الأرض ومرة أخرى كانت الأمة الألمانية العظيمة تقف في الطرف الخاطئ من الزمان و المكان تاريخياً ، وقفت إلى جانب الأتراك في حروبهم ضد صبوات الشعوب إلى الحرية و الانعتاق من الكرد والعرب والأرمن و البلغار و البوشناق..
وتذكر الوثائق أن خبراء الألمان و دبلوماسييهم وضباطهم كانوا على علم بالمذابح في حق الأرمن وغيرهم في فصل رهيب من فصول الطورانية المنفلتة من عقالها وزيفاناتها السامة وفيما بعد انكشفت هذه الوثائق وقد اطلعت عليها في كتاب وثائقي هام أرَخ لتلك الفترة القاتمة .
الطرق وسكك القطارات هي شرايين التواصل بين البشر لكن قطار الشرق هذا كان ذاهباً كالسيف في جسد الأرض و الناس ، فصل بين القرية الواحدة وبين الإخوة والأمهات والأبناء وأولاد العمومة وترك على جانبيه وما يزال الكثير الكثير من الآهات و خفقات القلوب الملتاعة والأمنيات المؤجلة لشعب يرفض القسمة على نفسه فكل سنبلة هنا ترفع قامتها لتتواصل مع شقيقتها هناك وكل شجيرة قطن هنا تهدي بياضها و نعومتها إلى أختها هناك وجذور السوس تتوغل عميقاً بين هنا وهناك والقباب المتكئة على الظلال والسحاب تتشارك أفراحاً وأتراحاً والنزعة التركية بعصابها القومي المقيت راهنت على امتداد هذه السكة الطاعنة ، راهنت على حقول الألغام والموت المخبأ تحت الأقدام التي لطالما تمزقت وبترت .
في أسواق و شوارع البلدة عندنا وفي الطرف الآخر كذلك ، مازلنا نرى رجالاً يتقافزون برجل واحدة أو أرجل مركبة ، إنهم ضحايا لعنة الألغام في سبيل التواصل وسلّ لقمة العيش عبر الحدود .
لا أدري لماذا كانت المنطقة المتاخمة للمحطة لها وقعها الخاص في وجداننا صغاراً و كباراً ، إليها مشاويرنا و فيها ملاعبنا ونزهاتنا المسائية و إذا جعنا كانت بساتين « مكر» والمختار وبكو وحبش سلة خضارنا , لقد كان للمكان سحره الأخاذ ونحن نتشوّف إلى الجانب الآخر من السكة مخترقين نظرة العسكري التركي الفظ وهو مدجج لا بالسلاح فقط بل بالحقد الطوراني ، حيث كان العسكري المسكين ببدلته الرثة يظن أنه من نسل الذئب الأبيض الذي هبط على شعبه من السماء بعد رحلة التيه ، هكذا لُقَّن الأتراك بكل هذا الغثاء القومي وسائر مفردات الحقد والكراهية للغير .
فالأساطير حين توظف بهذه الرؤية تتحول إلى عنجهية ماحقة وعداء مستحكم للآخرين .
أكثر المشاهد سحراً في منطقة المحطة والتي ماتزال حاضرة في الذاكرة كان المخفر الفرنسي المتهدم بأساساته الأربعة المبنية من الحجر الأسود و خرائب الغرف الملحقة به مبنية من الَّلبن « كلبيج » وكنا نسمي المخفر « قشلة » وهي تسمية تركية تعني « الثكنة» كان بناءً بطابقين يقال بأن البنّاء شهانو هو من بناه وباللصق منه كان جامع حج شامليان بأجوائه الظليلة وبعرائش العنب وأشجار التوت و بئره الطافحة بالماء ، كنا نلوذ به للراحة وشرب الماء وقطف العنب والحصرم في غفلة من الناطور ، صاحب الجامع هو الشيخ محمود شامليان كان معروفاً بتقاه و بسلامته .
في الجانب الآخر من المحطة كان أكثر مايلفت النظر خزان الماء الصدئ بلونه القاتم ، كان ينتصب عالياً وفي أعلاه يتربع عش طائر اللقلق الأليف بكل مهابته و نبله كان هذا الطائر جزءاً من المشهد وكنا نسمع شغب الفراخ بمناقيرها البرتقالية حين تحط الأم على العش الفاره حاملة وجبة الطعام من الضفادع والأسماك والثعابين. كان اللقلق يصطاف مع المصطافين في جانب البحيرة «الكولة»
بقامته الطويلة و بعباءته من الريش الأبيض والأسود في هجير الفقر والجوع ، كان خيالنا يرحل إلى ذلك العش الغامض الحنون ..نتساءل لماذا لا تكون لنا أمهات وآباء كهذين الطائرين يهتمون بنا و يحملون لنا الطعام اللذيذ ويطيرون بنا في سماوات الفرح وآفاق ملونة بالغيم الواعد فيما وراء حدود الخيال …؟
أذكر.. كنا نقترب متوجسين من السكة إياها .. كانت منشأة المحطة تبدو لنا غريبة مبهرة بأسقف من القرميد الأحمر .. هناك المظلة الكبيرة الواقية مصممة من حديد بسقف من توتياء وثمة حافلات هرمة مقعدة توحي بالكآبة وبزمن رحل ، وصنبور ماء ضخم يعلو ليزود خزانات القطار بالماء .. وإشارة مرور مزودة بجرس لتنظيم حركة القطار وهو يتحرك على شبكة متداخلة من القضبان الحديدية ريثما يمر القطار القادم.
في نهاية الخمسينات وبداية الستينيات نهضت فجأة صوامع الحبوب ، كانت من المعدن كنا نتابع البناء فيها مشدوهين كأنما يشرف عليها جن النبي سليمان بسبب ضخامتها وأحجامها العملاقة. واليوم ارتبطت كوباني بجلال هذه الصوامع الفضية وهي أول ما يشاهده القادم إلى البلدة قبل أن تنهض اليوم الأبنية البرجية ذات الطوابق الكثيرة .
في حرم المحطة أكداس من البضائع وحقائب المسافرين وأصوات العتالين وصافرة القطار القادم وناقوس الإنذار مشفوعا بجرعة من الصبر والانتظار ومن بعيد تلوح غيمة سوداء من الدخان ينفثه القطار التعب اللاهث .
أما نحن – الصغار- فكان لنا عالمنا الصغير، نمارس شقاوتنا مع الأطفال .
في الطرف الآخر نتبادل معهم التمر أحياناً والتمر عقدة الأتراك ونقطة ضعفهم التاريخية كما كان التبغ عقدة عندنا ، ولا أدري لماذا هاتان العقدتان ؟! نعطيهم التمر ويعطوننا التبغ والقمر الدين ومكعبات حلوى العنب والمكسرات كالبندق … وحيناً يتوتر الجو بيننا نتبادل رشق الحجارة ، حين نشعر بأننا أو هم قد خدعنا أو مسنا الغبن في عملية البيع والشراء هذه .
لا أدري …لماذا لا أريد الخروج من بهاء مشهد المحطة فالذاكرة تحتشد بالكثير من المشاهد النادرة ويومياتنا اللاهية في مهب أغبرة الصيف وأوحال الشتاء .
في تلك الأزمنة الجميلة وبالرغم من مرارتها و خيبات الطفولة وسطوة الكبار وأوامرهم ونواهيهم ، وحدها كانت مياه البحيرة و أشجار الحور والصفصاف وأشجار الدلب الأخضر كانت غسولنا من همومنا الصغيرة وأماننا النفسي .
في حرم المحطة كان مسرانا الأخضر مروجاً وشجراً وظلالاً منعشة وتيناً وحوراً ومشمشاً وتوتاً مشاعاً .
كنا نجوب وسط الماء والشجر مثل أناس الغابات الإفريقية ، لا حدود تمنعنا ولا تكشيرة مكر ويوسف توبال ولا صرخات عمتنا الطيبة
«غريبة» تحذرنا من الاقتراب من دجاجاتها وديكها الجامح بين نبات العليق.
في الشتاءات المخيفة كانت الأمكنة إياها تبدو مهجورة رمادية موحشة لا يقطع صمتها إلا نعيق الغربان وهي تجوب باحثة عن جيف تقتات منها .
كانت الأشجار تخلع ثوبها الأخضر وتبدو الأغصان العارية المغسولة بالمطر كأنها أذرع مبتهلة وتتكشف لنا الأعشاش فننظر إليها بكثير من الحنية والندم لأننا لم نكتشفها في الصيف .
في الربيع .. تعود «عشتار» ربة الخصب والحياة حاملة معها دورة الحياة الجديدة وتدب الخضرة من جديد وتهرب الأشجار من بؤسها ولونها الرمادي ويخرج الناس بعد أن مزقوا عباءة الشتاء السوداء والبيضاء و ودعوا الصقيع المتوغل إلى خلايانا .. ومواقد الحطب والشوارع الموحلة .
كنا نخرج مع النسوة في دورة جديدة للطبيعة نمارس طقوسنا مرة أخرى وكان الطقس الأكثر حضوراً هو تناول نبات شوكي طيب المذاق اسمه : «كربش» والنزول إلى ضفاف النهر لقطف نبات مائي بطعم حريف معروف عند الكرد هو « طوز وبندك» .
ومن الأسف أنه انقرض اليوم بانقراض الماء والينابيع .. واليوم لم يسمع كثير من الناس به وبغيره من الأشياء التي رحلت برحيل ناسها وأهلها وانتهت إلى حطام الذاكرة .
المحطة والناس والشجر والنهر كلها شكلت لوحة متكاملة من الطيبة والخير والجمال ودونها كانت البلدة كومة من تراب وحجارة وأحزان .
قطار الشرق مازال يسير ولكن بسرعة أكبر ولم يعد كما كان كسولاً متثاقلاً ، وكثير من المعالم مازال يقاوم الخراب والاندثار لكنه تغير بات القطار حديثاً وتجددت حافلاته وتغيرت الصافرة بصفيرها الرومانسي الذي طالما سمعناه في ليالي الشتاء الطويلة وانطفأت المشاهد والصور في ذاكرة من رحلوا إلى الأبد .
وتوقفت أيضاً مروحة مضخة الماء الوحيدة وهي تفتح أجنحتها للريح في كل الجهات ، تلك التي كانت في ساحة مقهى تانير ونجد مثيلاتها في منطقة النبك . أهي صدفة أن هذه الأشياء اختفت , مع تلبية الأرمن لنداء هجرة قدرية أخرى عام 1965 ولكن لا إلى المنافي بل عودة إلى جبل آرارات والهضبة الحمراء ….يريفان وإلى ديكران العظيم ، برحيل الأرمن أصبحنا في زمن آخر وجماعة بشرية أخرى .. تغير الناس وتناوبوا على هذه الأرض .
أما المكان فبقي شاهداً و نزيف الذكريات استمر ويستمر دون انقطاع .