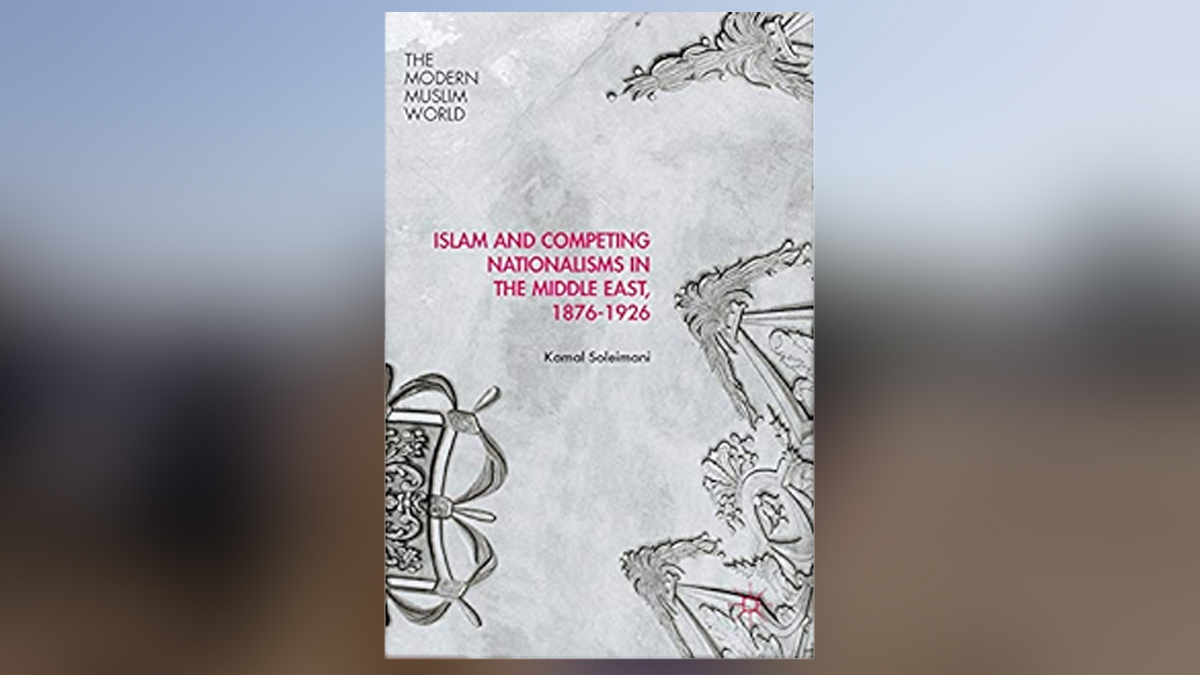Qiao Xinsheng
سوء فهم تاريخي:
إن فكرة ، أن النظام الاستبدادي لا غنى عنه لتطوير اقتصاد السوق قد لاقت القبول لمدة طويلة في الدوائر الأكاديمية الصينية, لأنه يتطلب درجة عالية من الكفاءة في السياسة. لقد حقق الاقتصاد التشيلي خلال دكتاتورية بينوشيه نموا اقتصادياً سريعاً, وأصبحت الفيليبين نجم آسيا اللامع اقتصادياً في ظل نظام ماركوس, وكذلك الأمر بالنسبة لإندونيسيا في ظل سوهارتو. وتبين هذه الأمثلة أنه فقط النظم الاستبدادية يمكن أن تحقق النمو السريع. وعلى الرغم من أن هذه البلدان استمرت في النمو الاقتصادي في ظل الحكومات الديمقراطية اللاحقة, فإن النمو لم يكن بالسرعة التي كانت في ظل الاستبداد. وتدفع الحجة باتجاه فكرة أنه خلال فترة التحول الاجتماعي يجب على البلد اختيار حكم استبدادي لأن الاندفاع النشط باتجاه الديمقراطية سيبطئ النمو الاقتصادي. فالصراعات العدائية بين الأحزاب السياسية لا تعيق النمو الاقتصادي فحسب بل تسبب الركود الاقتصادي.
الحكم الاستبدادي هو العدو الطبيعي لاقتصاد السوق:
صحيح أنه خلال عملية التنمية الاقتصادية لبلد ما, قد يدفع الحكم الاستبدادي نحو النمو الاقتصادي السريع ضمن فترة تاريخية معينة. ينطبق الأمر نفسه على الشركات, ففي المرحلة الأولى من حياة الشركة, قد يساعد تركيز سلطة صنع القرار في يد فرد أو مجموعة صغيرة على الاستجابة بسرعة ومرونة للتغيرات في السوق وقيادة الشركة من موقف القوة.
لكن إذا طبقنا هذه الظاهرة المحصورة بفترة محددة على مجمل تطور التاريخ الاجتماعي, واعتبرنا فكرة أن الحكومة الاستبدادية تؤدي إلى تطور اقتصاد السوق كحقيقة مطلقة, فإننا نتخطى مبدأ أساسيا أكاديميا(فكريا) ونرتكب خطأ منطقيا كبيراً. من أجل الاستفادة من كل الفرص في المعركة وضمان النصر في الحرب, فإن الدول المحاربة تطبق نظام صنع القرار في زمن الحرب, وتركز السلطة في أقل قدر ممكن من الأيادي. لكن منطق اقتصاد السوق يتطلب أعلى قدرة من المنافسة, الأمر الذي يعني نشر الموارد الاجتماعية عبر مختلف لاعبي السوق وتركهم يحددون الأسعار من خلال المنافسة, وبهذا يحققون الاستخدام الأكثر عقلانية للموارد. في النتيجة فإن الحكم الاستبدادي لا يسير فقط بعكس قوانين اقتصاد السوق بل عملياً هو عدو طبيعي لتطور اقتصاد السوق. فحالما يؤسس بلد ما اقتصاد سوق حقيقي, لا يمكن أن يحكم بشكل استبدادي. في المقابل, يجب أن تتطور الديمقراطية لأنها الطريق الوحيد لضمان اقتصاد سوق صحيح وضمان المشاركة في الثروة الاجتماعية.
عندما تعتمد دولة ما على الحكم الاستبدادي لتركيز موارد الأمة في أيدي أقلية صغيرة, فإن ثورات عنيفة ستخترق النسيج الاجتماعي. يضطر الناس الذين افقروا, جرَاء سرقة أرباحهم أو حتى فرصهم في كسب عيش محترم, للجوء إلى إجراءات متطرفة من أجل تغيير النظام الحالي. سيغرق المجتمع في الفوضى وينحدر للصراع العنيف من أجل الثروة. ووفقاً للنظرية الماركسية الكلاسيكية, عندما تتركز مجمل ثروة المجتمع في أيدي أقلية صغيرة من مالكي رأس المال, فإن الملايين سيستجيبون لدعوات “وحدة البروليتاريا”. إذا تطور هذا السيناريو , فإن المد المتصاعد من الاضطراب الاجتماعي سيقود للتوقف عن إنتاج الثروة وإعادة توزيع موارد الأمة لطبقة اجتماعية مختلفة, وفي كل الاحتمالات ستكون النتيجة تغيير الحكومة.
يرى بعض الدارسين أن بروز مجتمع [تسوده الديكتاتورية] يتميز بتوزيع للدخل تتوسع فيه الطبقة المتوسطة [يمكن أن يسوده] الاستقرار. لكن أخشى أنهم يضعون العربة قبل الحصان بهذا النوع من التفكير. لن تسمح الطبقة المتوسطة الجديدة للنظام الاستبدادي بالاستمرار في السلطة لفترة طويلة, بل كذلك في كل الاحتمالات, ستصبح الحافز الأقوى لتجاوز الحكم الاستبدادي. سيأخذ أعضاء هذه الطبقة الفئاتَ الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا إلى الشارع في حركة من أجل الحقوق الديمقراطية. بكلمات أخرى, ستطلب المجموعات الهامشية والضعيفة حصةً من المنافع المادية للمجتمع, و ستطلب الطبقة المتوسطة المالكة الحقوق السياسية. وهذا هو سبب نزول المجموعات الهامشية في الفيليبين (كمثال للحكم الاستبدادي) إلى الشارع لاستنكار الفساد, وكانت الطبقة المتوسطة, بعدهم مباشرة, تطالب بالحقوق السياسية. قادت الاحتجاجات في الشارع إلى صراع برلماني, وفي النهاية تم خلع ماركوس. يمكن أن نستخلص من ذلك أن النظام الاستبدادي الذي يطور اقتصاد السوق عملياً يحفر قبره بنفسه. لا تمتلك الطبقة المتوسطة فقط الأساس الاقتصادي لحماية نفسها من عقوبات وانتقام النظام اقتصادياً, بل نظراً لأن أعضاءها على درجة عالية من التعليم, فإنها تستطيع أن تستجر دعم الإعلام من أجل تنظيم المجموعات الهامشية وجرها للشارع, وتحويل صراع الشارع إلى صراع برلماني من أجل الديمقراطية. الباحثين والأكاديميين الذين علقوا آمالهم على أن ينتج الحكم الاستبدادي اقتصاد سوق حقيقي, إما أنهم يشوهون التاريخ من أجل تعديل صورة النظام, أو يستنتجون أن ظاهرة مقصورة على فترة تاريخية معينة تسري بشكل عام. وفي كل الأحوال يخترقون أسس البحث الأكاديمي.
تطوير الديمقراطية وتطوير اقتصاد السوق, على نفس الدرجة من الأهمية:
إن تطوير الديمقراطية وتطوير اقتصاد السوق هما على نفس الدرجة من الأهمية. عندما لا يكون للجمهور سلطة صنع قراراته الخاصة, لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد سوق. و عندما يستبعد المواطنون من عمليات صنع القرار, فإن السياسات التنظيمية الحكومية [على مستوى الاقتصاد] الكلي يمكن أن ترتكب أخطاء كبيرة. عندما يرى حفنة من الحكام, الذين فرضوا أنفسهم, أن مركزية السلطة هي آلية صنع السياسة الأكثر كفاءة ويفعلون ما يريدون بشكل متغطرس, فإنهم يفشلون في إدراك أن هذه الطريقة في تنمية الاقتصاد ليست فقط قصيرة الأمد بل خطرة. وباعتبار أنها مكشوفة للفساد الكبير فإن هذا النوع من الإصلاح الاقتصادي ليس قابلاً للاستمرار وليس شرعيا أيضاً. وعندما يصل هذا الإصلاح إلى مرحلة معينة, فإن آليات السوق يمكن أن تتعطل مسببة تصدعات في الهيكل السياسي.
تثبت الحقائق أنه, عندما يستبعد الناس من عملية صنع سياسة الإصلاح , يصبح الفساد مشكلة كبيرة. والسبب الذي أدى لإنتاج عملية إصلاح الشركات الحكومية الصينية لهذا العدد من الموظفين الفاسدين, هي أن القيادة التنفيذية للإصلاح تركزت في يد عدد صغير من الموظفين. بدايةً, يتم إجراء الرقابة والتوازن في نظم صنع القرار في الشركات, لكن في الواقع فإن عدد قليل من الناس في القمة يصنعون القرارات التحكمية والنهائية. عندما يطور عدد صغير من صانعي السياسة الاقتصاد تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي, فإنهم في نفس الوقت يحولون أصول الشركات الحكومية لملكيتهم الخاصة. وتشير مجموعة من القضايا المتعلقة بالفساد في البنوك التجارية الحكومية في الصين, في السنوات الأخيرة, إلى أن هذا النمط من الإصلاح ليس أكثر من خطة لإعادة توزيع الثروة و التي لا تساهم في الرفاه الاجتماعي ولا يمكن أن تستمر طويلاً. مع تركيز كل ثروة المجتمع في أيدي قلة قليلة , يأمل صانعو السياسة أن تتوقف آليات اقتصاد السوق قريباً عن لعب أي دور. وكنظام مؤسسي تحل الإدارة الاحتكارية (احتكار القلة) محل الاقتصاد المخطط في تخصيص الأصول المادية, وينقسم المجتمع إلى رابحين (الذين لهم مصلحة مع النظام) وخاسرين ( الذين ضحى بهم النظام). وأكثرية الذين استبعدوا من عملية صنع القرار السياسي يمكن أن يبحثوا عن الفرص ليفرغوا غضبهم ويكتشفوا قيمتهم الاجتماعية من خلال أدوات الثورة المتطرفة التي يمكن أن تدمر النسيج الاجتماعي.
يعبر الاستبداد حول العالم عن نفسه بطريقتين: الأولى, في تخصيص الموارد الرأسمالية, والتي يمكن التعبير عنها بالاستبداد الاقتصادي, والثانية, في حكم الاستبداد السياسي. لا يمكن تجاهل أنه في البلدان الرأسمالية, تتم ممارسة السيطرة الاستبدادية بشكل عام على تخصيص موارد رأس المال, باعتبار أن عددا قليلا من المستثمرين يسيطرون على مبالغ ضخمة من رأس المال ويستخدم رأس المال هذا في توظيف العمل المأجور وخلق القيمة الزائدة. لكن نظراً لأن البلدان الرأسمالية هي ديمقراطية بشكل عام, فإنها تعمد لاستخدام الأدوات الديمقراطية للحد من الآثار السيئة لديكتاتورية رأس المال. إن المواطنين الذين يشكل عملهم أصولهم الاقتصادية الوحيدة في سوق تنافسية يمتلكون حق الاقتراع على الأقل, و الذي يمكنهم من التعبير عن رأيهم. للحصول على صوت المواطن, يضطر السياسيون في الظروف العادية إلى إجبار مالكي رأس المال للتخفيف من سيطرتهم على عمليات صنع القرار والتخلي عن جزء من حصتهم من ثروة الأمة. على سبيل المثال فإن الأحزاب اليسارية في العديد من البلدان الديمقراطية تميل لزيادة الضريبة على الأثرياء من أجل إقامة نظم الضمان الاجتماعي والرفاه الاجتماعي التي تلبي حاجات المعيشة الأساسية للفئات الفقيرة والمهمشة. في المقابل فإن الأحزاب اليمينية قد لا تكون مستعدة للتجاوز على المصالح الخاصة الأساسية, لكنها تخفض الضرائب لجعل القدرات التنافسية للشركات أعلى, ولخلق ثروة أكبر للجميع بما فيهم الفقراء. نتيجة لذلك يجب أن تتم الرقابة على دكتاتورية رأس المال من خلال الديمقراطية السياسية, بينما تقدم الديمقراطية ضمانات خارجية للتنمية الاقتصادية. إن أي محاولة للاعتماد على الاستبداد السياسي والاقتصادي لتحقيق نمو اقتصادي سريع, سيؤدي بشكل محتم إلى إثارة المشكلات الاجتماعية, وسيمثل صورة خاطئة لازدهار النمو الاقتصادي, وفي النهاية سيثبت مساراً غير قابل للاستمرار للتنمية الاقتصادية. بين التاريخ, مرات عديدة, أنه حينما يترافق الاستبداد الاقتصادي مع الاستبداد السياسي, فإن اقتصاد البلد سيسقط في النهاية.
ويبقى الاقتصاد الصيني, البلد الواقع في منتصف التحول الاجتماعي, في العديد من جوانبه خصوصية صينية فريدة. على سبيل المثال فإن نسبة كبيرة من لاعبي السوق هي إما شركات حكومية أو شركات حكومية حولت إلى شركات مساهمة. بموجب الدستور الصيني, يمتلك مجمل الشعب أصول هذه الشركات , لكن في ظل التشريع الحالي , أصبحت الملكية للدولة. وفقاً لقانون الشركات, تحول الحكومة أصول الشركات الحكومية إلى عدد قليل من صانعي قرار الشركة ومدراء الأصول المملوكة للدولة , الذين يعملون بشكل دائم على تحويل هذه الأصول إلى أصول خاصة لمصلحتهم الشخصية. لذلك إذا لم يتم التأسيس للديمقراطية في الصين حالاً, ومع استمرار الاستبداد الاقتصادي الحالي, فإن كل الثروات التي كسبت بجهد الشعب الصيني ستصبح ملكية خاصة لقلة قليلة. وإذا سمح بهذا الوضع أن يتطور أكثر, فإن ثورة عنيفة ستهدد, في النهاية, حكم الحزب الحاكم. حتى لو تم النقاش من منظور التسليم بأن الحزب الحاكم يجب أن يبقى حاكما, فلا يزال هناك ضرورة لتسريع بناء السياسات الديمقراطية بالتوازي مع تنمية الاقتصاد الوطني. ونظرية أن الحكومة الاستبدادية تؤدي إلى تطوير اقتصاد السوق هي سوء فهم تاريخي. تبنى هذه النظرية عدد قليل من الأكاديميين, لكن هذه النظرية المضللة ترجمت مسبقاً إلى سلسلة من السياسات الحكومية التي قادت إلى مشكلات عميقة. لذلك فمن أجل تصحيح كل أنواع المشكلات التي تنتج عن اقتصاد السوق, ومن أجل تمكين الفئات المهمشة, التي تفشل في الاستفادة من السوق التنافسية, من ممارسة حقوقها في حرية التعبير ضمان إطار المجتمع الديمقراطي, فإن الديمقراطية السياسية يجب أن تطور بالتوازي مع اقتصاد السوق.
إن قلة من الأكاديميين الذين جادلوا بأن آليات صنع القرار على المستوى المصغر, مستوى الشركة, يمكن أن تطبق على المستوى الكبير, مستوى الدولة, يفتقدون الدقة الأكاديمية. أحد المبادئ الأساسية لنظم حقوق الملكية هي أن الافراد يستطيعون استخدام ممتلكاتهم الخاصة بالشكل الذي يرونه مناسباً بدون تدخل حكم استبدادي. حقوق الملكية الواضحة والحاسمة تضمن أن أي مشارك في السوق يمكنه أن يمتلك ويستخدم ويتخلص من ممتلكاته, وأن يربح منها. من بين أعظم إنجازات الحضارة البشرية هي استخدام العمل من قبل رأس المال, وحماية حقوق الملكية في مختلف البلدان, وتأسيس نظم منطقية لتخصيص موارد رأس المال, وحماية الحقوق القانونية وحماية مصالح أرباب العمل والمستخدمين في الشركات. على سبيل المثال فإن قانون العمل وقانون عقد العمل يحميان حقوق ومصالح العمال ويشجعونهم على المشاركة في صنع قرارات المشاريع في ظل شروط محددة و واضحة. يقدم هذا النوع من التشريع ترتيبات مؤسسية تتوافق مع المفاهيم التقليدية للملكية, وتساهم في الاستخدام العقلاني للثروة في المجتمع الحديث, وترعى المسؤولية الاجتماعية في الشركات, وتحمي المصلحة العامة. إن الأكاديميين الذين يرون درجة عالية من الكفاءة في الإدارة الاستبدادية, يتجاهلون عمليات صنع القرار الديمقراطي في الشركات, ويتجاوزون ذلك إلى مناقشة فكرة أن الإدارة الاستبدادية يجب أن تطبق على المجتمع ككل, هم ببساطة يبحثون عن الذريعة للحكومة الاستبدادية. وهذا النوع من التبرير المدرسي ليس له معنى.
استخدام الديمقراطية السياسية كشكل من الرقابة والتوازن على الاستبداد الاقتصادي:
بناء السياسة الديمقراطية في الصين المعاصرة يجب أن يتسارع ليس من أجل إعادة توزيع السلطة السياسية- فالدستور الصيني مسبقاً يقدس مبدأ أن الشعب مصدر السلطة- لكن من أجل حماية حقوق الملكية المشروعة للناس. ما لم يتسارع بناء السياسة الديمقراطية, وما لم تستخدم الديمقراطية لتوفير الرقابة والتوازن على الاستبداد الاقتصادي , وما لم يتسارع إصلاح النظم الإدارية, ومالم يتم التأسيس لنظام يشرف على الأصول الجديدة التي تمتلكها الدولة فإن ثروة الشعب ستستنفد. وفي الحقيقة فإن مقدار أموال الشعب التي تنفق من قبل صانعي السياسة الصينيين على أنفسهم ستزداد بشكل مستمر. إن أكثر من ثلث الموارد المالية تنفق على “تكاليف رسمية” لدفع الأسفار الخارجية وتعليم وتدريب الموظفين وشراء سيارات خاصة لهم وبناء مكاتب ومنازل لهم على كل المستويات. إذا كانت مشكلة الاستبداد الاقتصادي لم تحل من خلال الديمقراطية السياسية وحاولت الحكومة تقوية الرقابة الاستبدادية من أجل تطوير الاقتصاد, فإن الاضطراب الاجتماعي سيثور ويتصاعد و سيصعب تحقيق هدف التنمية الاقتصادية المستديم.
لأن أكثر المستثمرين يمتلكون روابط وثيقة مع موظفي الحكومة في البلدان المحكومة بنظم استبدادية, وشكلت مجموعات مصالح ضمنها, فإن الاستقطاب الاجتماعي أمر حتمي كمنتج ثانوي للتنمية الاقتصادية. هناك قلة قليلة غنية جداً أما الغالبية العظمي من السكان فتعيش في فقر مدقع. لذلك حالما تصل اقتصاديات تلك البلدان لمستوى معين من التنمية , فإن الحركات الثورية ستبدأ بالظهور حتماً. وستؤدي الاضطرابات الاجتماعية إلى إسقاط النظام , و سيتم نفي أو سجن رجال الأعمال المنتمين إلى الزمرة الحاكمة, وسيدخل الاقتصاد في حالة من الانهيار. وهكذا فإن التنمية الاقتصادية في ظل الحكومة الاستبدادية هي ظاهرة اجتماعية غير عادية ومؤقتة. وهذا النمط من اقتصاد السوق ليس غير قابل للاستمرار فقط, بل إنه يميل أيضاً لأن يكون عرضة للثورة.