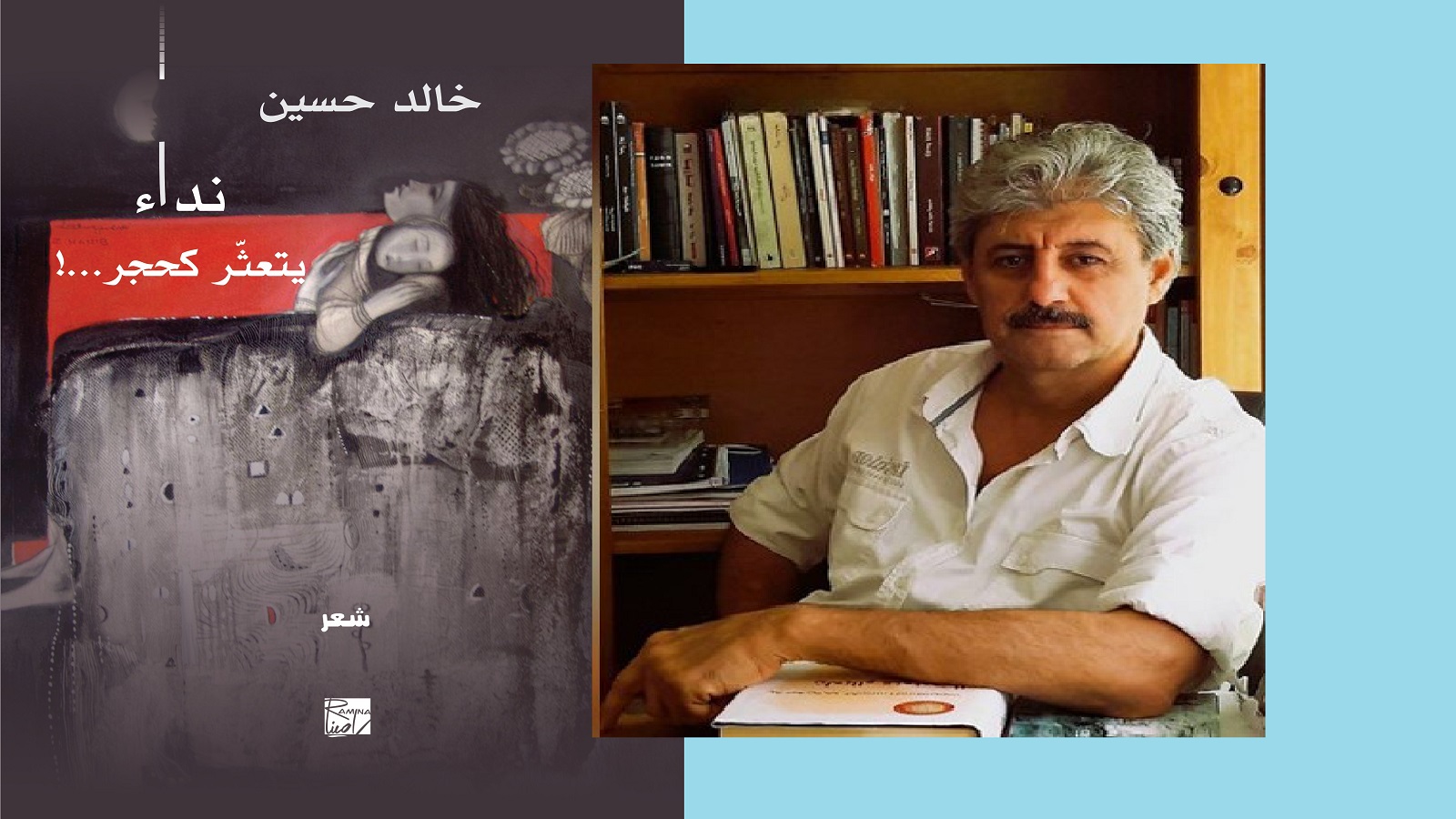“أحبُّها تلك البلاد
حتَّى في خرابها الأخير.”
يَنبثقُ النَّصُّ الأدبيُّ تحت ضغوط ألعاب التَّشفير Codification بوصفه واحداً من العمليات الأساسية في بَنْيَنَةِ العَلامات الأدبية، أي بناء سياقٍ سيميائي لعَلامات اللغة ضمن نسقٍ نصيِّ يقتربُ من السياق التداوليِّ للغة وينزاح عنه، وبموجب هذه “العملية” تندفع العَلامات بفعل تمرُّدات المخيّلة من التشفير ــ البدئي/ التداولي إلى ترميزٍ معَّمى، أكثر غموضاً وتعتيماً، وبناء على ذلك يمكننا إحداث تفارقٍ بين كينونة اللغة الجمالية وممارسات أخرى في فضاء اللغة؛ ولذلك ترى هذه القراءة في “التشفير” قانوناً من قوانين بناء “العمل الأدبي” واستناداً إليه ستجري مساءلة مجموعة الشاعرة وداد نبي “الموت كما لو كان خردة، دمشق: بيت المواطن ـ 2016″.
إنَّ المتأمِّل في نصوص المجموعة سيَلمَس إخضاع الشَّاعرة مساحاتٍ من نصوص المجموعة (وهي في الحقيقة ضيقة: كلمة، شذرة، مقاطع هنا وهناك) لضغوط التشفير وألعابه وفي الوقت ذاته سيلحظ إفلات مساحات واسعة من هذه النُّصوص من فعل التَّشفير وممارساته؛ لتمارس كينونتها في فضاء الجنس الشِّعري في لغة تعادي التعتيم وتقترب من اللغة الشِّفاهية، ولذلك لن يبذل القارىء جهوداً تأويلية بمحاصرتها والتنائي عنها. في إطار هذا التفريع الثنائي بين حضور “التشفير” وغيابه تتأسس العلامات اللغوية اقتراباً من “الكتابة الشعرية” أو ابتعاداً عنها.
يبدأ التشفير الشعري ممارساته بدءاً من عنوان المجموعة:” الموت كما لو كان خُردة“، هكذا بأربع علاماتٍ يكثّف العُنوان مأساة بلدٍ مثل سوريا كينونةً وأمكنةً وبشراً وشجراً. ولا شكَّ أن قوة التشاكل هنا بين “الموت” و”الخُردة” هو الذي يبثُّ الدهشة لدى القارىء، فالموت ـ من حيث هو حدثٌ أنطولوجي” لم يكن في أيِّ وقتٍ بهذه السهولة في حياة السوريين كما يحدث الآن من حيث رهبتُهُ حدثاً ورعبُهُ تجربةً بالتوازي مع كائن مثل”الخُردة”، الخردوات تلك المخلفات المعدنية التي فقدت صلاحيتها الأدائية وانزاحت عن سياق العمل. حدث أنطولوجي، كالموت، بكل هيبته وثراء تجربته ومرارته يغدو متشاكلاً ومتماثلاً مع الاعتيادي واللأدائي: “الموت = الخُردة”، لكن العنوان الشعري هنا يرواغ التشبيه البليغ ليتجسد في تشبيه ناقص عبر الاحتفاظ بأداة التشبيه “كما لو” للإبقاء على حدٍّ فارقٍ يمنع التماهي مع حدث جليل مثل الموت وضديده “الخردة”.
هذه الكثافة الدلالية المتجسدة، عبر العنوان وفيه، تتفتَّح في جسد النُّصوص بأشكال دلالية مختلفة من الممارسات الشِّعرية للتشفير؛ إذا يتخثّر عن هذه التراجيديا “الموت = الخردة” غيابٌ ثقيلٌ يلتهم المكان؛ ليغدو الغيابُ عنواناً للأمكنة:

وداد نبي
“أزهار الصبار/ تنمو في أحواض المدن/التي هجرناها…ص9”. إنها لمفارقة أن تغدو ميادين المدن موطناً لـ”نباتٍ” حوشي، صحراوي، يستغل غياب الناس ليمارس كينونته، محوِّلاَ المدن إلى فضاءات قاسية لاتصلح للكينونة. هذا مافعله الموت المجاني، “الموت = الخردة” الذي سلّطه كائن متوحش على حواضر تاريخية، ليتحول المكان إلى أنقاض مهجورة تأبى نسيان ساكنيها: “الأسى/ هو أن تزور أنقاض بيتك في الحلم/ وتعود منه وقد علق الغبار على يديك، ص10“. هنا يكمن السرُّ في العلاقة بين الكائن والمكان، كلاهما يمتدُّ في الآخر، ويرتبط به، هكذا يعيش فينا البيت “بيتك” الذي تصطخب فيه الذكريات التي تتجسد في صورة “الغبار”، فما أن تغمضَ عينيك حتى ترافقَك الذكريات/ الغبار إلى المأوى الجديد. إن العنوان، بوصفه نواةً دلاليةً أساسية، يتنامى ويولِّد دلالات تتولى تفسيره في متون النَّص: “يدُكَ العالقةُ على جرس بيتك القديم/ من يخبرها: المنازل ليست لمن رحلوا عنها !، ص 11”
فالبيت، “بيتك القديم” الذي شهد الصرخة الأولى للكينونة، العالم الذي يحتفظ بأسرار هذه الكينونة مايزال حاضراً ويرفض مغادرة فضاء الروح إلى حدِّ أنه يحتفظ باليد “يدك” هناك، فهذه “اليد” بمنزلة علامة على مِلكية “بيتك”، لكن ثمة ما يطعنُ الرُّوحَ في هذا التنائي الحاصل بين الكائن والمكان، إذ أدلى الكائن المتوحش بما مفاده “الأرض لمن عليها”، ليسرق “المكان” من ساكنه حتى يبقى متشرداً في أصقاع الأرض بعد أن قام بتدميره بروح شريرة تدفعها غرائز طائفية مقيتة. هنا تتلفّق الشاعرة سردية “الحاكم الطائفي” وتصوغها بلغة أخرى:” المنازل ليست لمن رحلوا عنها !” لتحدث هوةً بين “بيتك القديم” و“بيتك القديم” الذي أضحى الآن تحت طائلة الاغتصاب والتعفيش وإلغاء ذكرياتك وشطبها من الوجود.
تمضي الشاعرة بقوة تشفيرية في تجسيد هذا الغياب الاضطراري عن الأمكنة في الحالة السورية عبر النصوص ولاسيما في الصفحة(11)؛ فالماء وحده يدرك بكاء الزهور في الشرفات المهجورة من أهلها وناسها، كما يلتبس على المنفيِّ إنْ كان ما يلمسه أهو “حديد الحافلة” أو “المقبض الحديدي لباب بيتك هناك” ليتماهى مقبضُ الباب وحديد الحافلة “فتنمو نرجسةٌ”، هكذا يمتصُّ المكان الأول أمكنة المنفى؛ ليكون ذلك علامة الوفاء لأصحابه الذي هُجّروا تحت طائلة المطالبة بالحرية والحياة الكريمة وبدوافع طائفية شريرة تقيأها الطائفيون على الكينونة السورية. تتصاعد هذه التراجيديا في هذه الشذرة الشعرية بقوة: “الحياة لن تكون بهذا السوء/ ستمنحكَ بيتاً جديداً، لكن روحكَ ستبقى ذئباً/ يعوي كل ليلةٍ/ على أدراج بيتكَ القديم. ص12”. إن المأساة التي عصفت وتعصف بالكينونة السورية ترتّب عليها غيابٌ ثقيل من جراء مئات الآلاف من القتلى، ملايين المشردين خارجاً وداخلاً، مدن منكوبة، مدمّرة،… وكلُّ ذلك من أجل بقاء “كائن متوحش” في السلطة تدعمه شبكات اجتماعية محلية غارقة في الطائفية وأخرى إقليمية ودولية تبحث عن مصالحها على حساب الكينونة السورية. هذه المأساة فتحتِ الفضاء السُّوري على غيابٍ ثقيلٍ لا يني يتخثَّر في حَيَواتِ السُّوريين في غربةٍ قسريةٍ جعلت المنفى يستحيل عذاباً وتمزقاً لا يتلاشى ولا يلتئم، لذلك يحضر “المكان الأول= بيتك القديم” على نحو عنيفٍ؛ فهو يحتفظ بروح كائنها التي سرعان ما تتلبَّس كائنية ذئبٍ يملأ فضاءات البيت بالعواء كنايةً عن حضورٍ عميقٍ بين الكائن والمكان. هكذا نعيش أمكنتنا، بيوتنا، أسرتنا التي لن تُنتَسى بسهولة، لأنها تتخذ أشكالاً مختلفة ليحتفظ بها القلب: ” في قلبي ندوب المدنُ/ التي تركتها/ المدن التي/ تتبدّدُ كسكرٍ هشٍّ/ في ماء البرابرة الجدد. ص 78″. تغدو المدن/ الحواضر التاريخية ندوباً على حواف القلب، فهذه الحواضر التي قاومت أحداث التاريخ وصدمت في وجه الزمن، هاهي تتبدد بفعل قوى عاتية (البرابرة الجدد) جاءت لتنتقم من”المدنية” التي نشرتها هذه الحواضر وأضاءت بها العوالم الأخرى، فالبرابرة الجدد لم يكونوا سوى برابرة طائفيين يدفعهم الغلُّ والحقد و رؤى سوداء للانتقام من المكان.
إن المكان في المجموعة يأتي صدى قوياً لثيمةِ العنوان “الموت كما لو كان خردة” حيث يتعرّضُ لضغوط التَّشفير التي تخرجه من الحالة الفيزيائية إلى حالة أنطولوجية تمهيداً لصياغته شعرياً: “أحبُّها تلك البلاد/ حتى في خرابها الأخير..ص9” كما لو أن الشاعرة تصوغ العنوان ثانيةً وبعلاماتٍ مختلفة؛ فالتدمير(=الموت) الذي أحدثه “الحاكم الطائفي” للفضاءات السورية أحالها إلى “خُردة= خراب” لا قيمة لها/له، لكن حتى في هذا الخروج عن صلاحية العيش لما طالها من دمار ونهب، فإن هذه “البلاد” ستظل موضوع التواصل والوصال بين الكائن والمكان في إشارة إلى أن العلاقة بينهماالمكان لن تنتهي على الرغم من الفعل البربري الذي قام به الكائن المتوحش بقصد تحقيق رؤى سوداء عبر إفراغ المدن من ساكنيها. لكن التقاطع بين العنوان الرئيسي للمجموعة والمتون النصية تبرز بقوةٍ في نصٍّ موسوم بـ”الجرح كما لو كان خردة“. هنا العلامات تكاد تتكرر في الصيغتين، فمن حيث الدلالة يختلف “الموت والجرح” لكن كليهما يمضي إلى أن يكون من المخلفات الفاقدة للصلاحية؛ أي يتوحَّد الحقل الدلالي الذي يضمهما. هذا التلاقي بين العنوانين يَهَبُ المجموعة الشعرية نوعاً من التماسك البنيوي من حيث التلازم بين العنوان والنصوص؛ ليأتي العنوان دالاً على نصوص المجموعة وفياً لها بوصفه الهوية التي تميز هذه المجموعة.
لا تمضي نصوص المجموعة في هذا السياق التَّشفيري الدَّال الذي يحفّز القارىء على الاشتباك مع النَّص واللعب معه على الصعيد التأويلي، فثمة مساحات من نصوص المجموعة تخرج عن إطار العملية الإبداعية وتنزع نحو محاكاة تجارب شعرية سابقة على صعيد قصيدة النثر، حيث تبدو المحاكاة واضحة بين نصوص (لأنك معي أيها الحب ص26، يحبني عشرون رجلاً ص 29، حُقنة بوتاسيوم لموتٍ سهل ص 32، قبل الثلاثين بقليل. قبّلني ص42…إلخ) ومجموعة رياض الصالح الحسين “أساطير يومية”، فالمحاكاة هنا تندرج ضمن سياق التناص التماثلي، لذلك تفتقد هذه المساحات النصية إلى الاختلاف والتكثيف الدلالي والصُّور الشِّعرية المبتكرة إلا فيما ندر. من جهة أخرى وفي هذا السياق من العطالة الشعرية نجد أن بعض التراكيب لدى الشاعرة تقع في إطار السائد من الكتابة الشعرية المستهلكة من مثيل: وحده الماء يعرف ص11، وحدها طرود البؤس تسقط…ص13، وحدها الكراهية لم تشتر ..ص15، وحدها النافذة التي تطلُّ على …ص84..إلخ. أما بخصوص نصوص لـ”كوباني” فأعتقد أنها لم تشي بـ”شعر التجربة”، بقدر ما ظلَّت طارئة، وتعاني من تلكؤٍ في الجملة الشعرية وصياغتها.