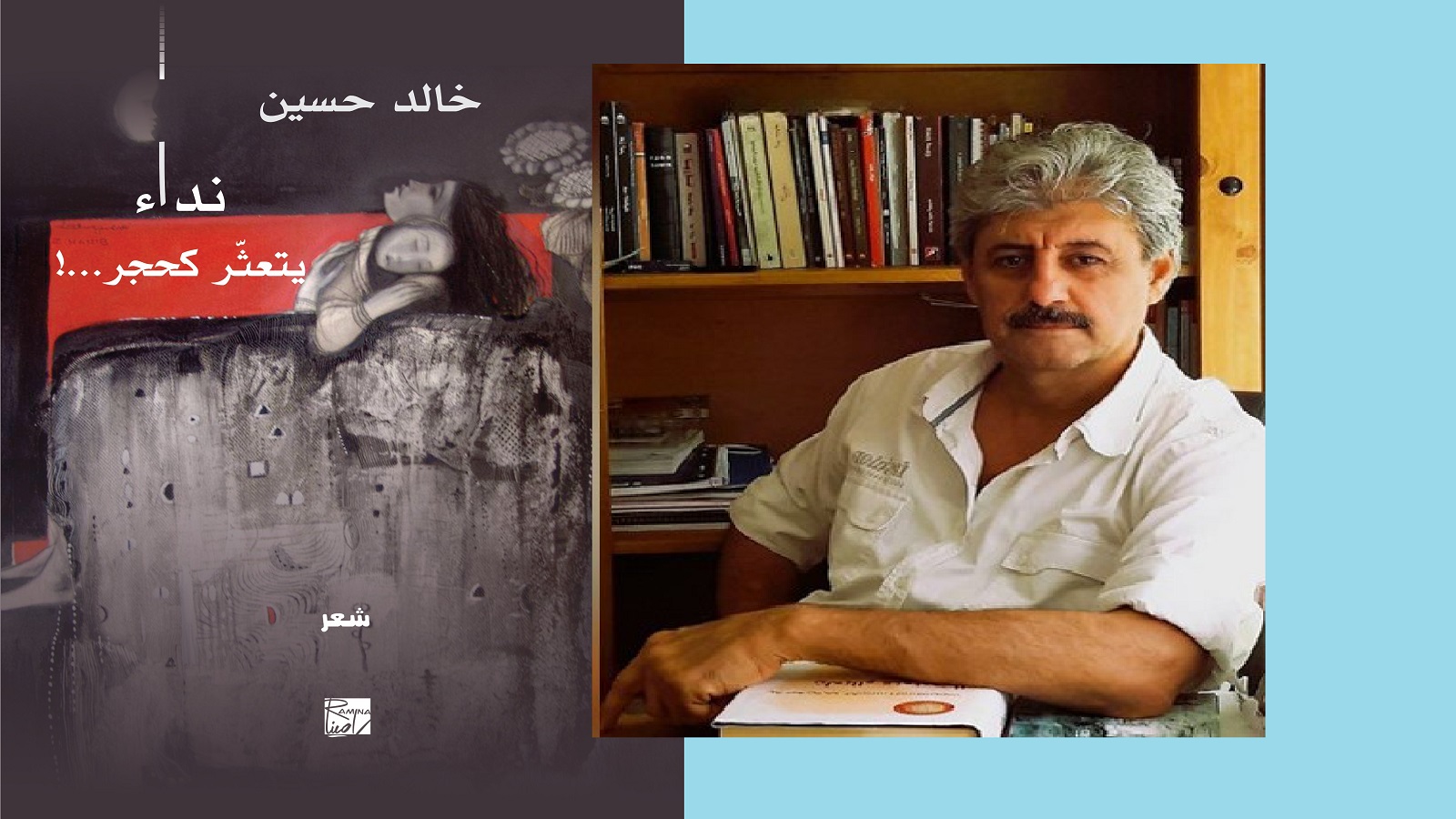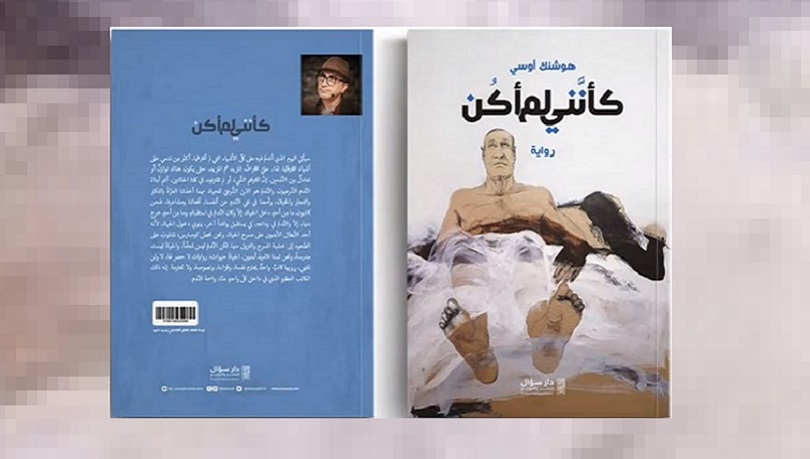إنّ القراءة المفترضة لأيّ نصّ أدبي تستلزمُ شروطها، إذ تشدُّ القارئ وتسحرُهُ بالعناوين، والبدايات والاستهلالات والنهايات، ولكن أمام نصّ بلا عنوان، وبعتبة بهيّة وحضور لنون النسوة الطّاغي على جسدية النّصّ، تمكّنَ الكاتب جوان حمي أن ينسجَ شروطه، حبائله وفخاخه في غياب للعنوان، فـمن خلال بداية سرديّة، يتركُ قارئه أمام أفق التّأويل لحضورهنّ/ للكرديّات، فأيّة آهةٍ تدفعُه، ليتكهنَ بالمصير المفجوع لهنّ، ودوام الوجع عليهنّ، والحسّرة على الغياب العميق منهنّ ..!!
هنا؛ أمام نصٍّ يؤرّخ الألم بكل جهاته، لا تنظير ولا سجال نقدي على مستوى القراءة، هو النّص المفتوح على ألمه الخاص، الألم الذي يبترُ فيه كلّ نهار ــ ألم الكرديّات/ أختي، أمي، ابنتي، جارتي، صديقتي، وأخوة كلّ الجبهات، إنّهُ الألم الذي يتجزأُ أمام العالم، ولكنه ما تجزأ يوماً أمام أصابع الدم الكردي ــ يبترُ الطبيبُ دونَ أن تتنـّملَ أصابعه المغطاة برائحة الدم ــ دم الأخوة/ الجهات ــ وهو يرتقُ مفاصل حكايات زائريه، وهم يأتونه أشلاء ــ فتشدُهنَ الرائحة لليدِ التي بُتر قلبه منذ زمن، هو توصيف للأم الكُردية التي تستشعرُ دون معرفة مسبقة، إلى رائحة دم ابنها، أيّة قوة وصلابة قلب تحتاج الأمهات حتى ترشدهم الدّماء إلى أبنائهنّ: “إنهنّ يستشعرنَ ذلك بغريزة الدّم المُراق، إحدى الــ “المهاباديات”؛ وكنتُ قد أخفيتُ عنها نبأ وفاة ابنها بين يديّ في غرفة العمليات، ما انفكتْ هذه الأم تشمُّ يديّ ــ حيثما تراني ــ “أشمُّ رائحة كبدي من يديك”.
يقول رولان بارت/ الناقد الفرنسي الشهير: “إنَّ الافتتاح منطقة خطرة في الخطاب، فابتداء الخطاب أمرٌ عسير، إنّهُ الخروج من الصمت”، وكأن الكاتب/ الطبيب الممتهنُ للبترِ، لا خطورة أمامه ولا حجرة عثرة ليخرج بكامل الصمت ويرميه أمام أقدامهنّ، هكذا يبتدىء الكاتب بخطاب مباشر، خطاب توصيفي لهنّ، خطاب المكاشفة لشتاتِ أمة، ودون أداة للنداء/ لندائهنّ “لا واو للندبة لديهنّ، فالكردية لا تبكي عزيزاً لفقده ورحيله الأبدي، بل تبكي لائمةً نفسها على تقصيرٍ ما بحقه “هؤلاءِ هنَّ الكورديات، اللواتي بكاملِ ألمهنّ، والكاتب إذ يحرر بذلك “مقولة الجنس” عندما يبتدئ نصه بلا مراوغة فيه، بنون مؤنثة مؤكدة للمرأة، ليرتقي بألمهنّ “الكورديات الجميلات، الطويلات أو القصيرات، الممتلئات أو النحيلات، البيضاوات أو السمراوات”، حتى لو كنّ مختلفات في لونهنّ، طولهنّ، وأشكالهنّ، فثمّة اتساق وانسجام بينهنّ، فــهنّ “أميرات حزنٍ أزلي، لا أحد يُخزّنُ الحزن، يخمرهُ، يعتقهُ بقدر الحزن المعتقِ في قلوبهنّ، … وصلاحية أيام الفرح لديهنّ منتهيةٌ أبداً“، فأحزانهنّ المطرزة بآلام الفقد مرّة، ومرّة بآلام الرثاء لفلذات أكبادهنّ، ثمّة إرادة وعزيمة لا تكسرها ألف بندقية ورصاصة موجهة لأجسادهنّ وقلوبهنّ التي لا تعرفُ عطراً سوى رائحة التعب، لا رائحة تملأ صدورهنّ إلا رائحة الأعزاء الراحلين، أجسادهنّ/ قلوبهنَّ التي تعرفُ كيف تصوّبُ بياض روحها وقد تخضّبت بألم دمائهنّ، للرايات السوداء، ولقلوبٍ لا تتقنُ إلا نداء الموت، إنّهُ الإيقاعُ الأجمل للحياة، في مواجهة العقول السوداء، هي لوحة ساحرة في مقولة القناصة الكردية وهي تسترسلُ في إجابتها على تساؤل السّارد العليم بكلّ الحدث، وكأنه يحفّزُ الألم ويزيدُ من منسوبه، ويرسمُ له شروط ومؤشرات تأتي في دلالاتها الكاملة:
” ــ كيف تقنصينَ ذوي البيارق السوداء؟
ــ ضحكت مليّاً: كمية السواد في قلوبهم ترشدُ رصاصتي ..!!!
قلوبنا البيضاء ترشد رصاصتي إلى سواد عقولهم، رصاصتي تقتلُ السواد أينما كان”.
هنا مكمنُ الألم بكلّ أبعاده الثلاثة، حيثُ الآلام الباقية بعد البتر.
يقول الكاتب في نصّهِ: “من تهافت الطغاة عليهنّ؛ الذكوريين؛ أشباه الرجال، والدكتاتوريات
من توالي الشاهنشاهات، وخلفائهم من آيات الله
سلاطين آل عثمان؛ سيوفهم ذات الأهلّة الثلاث وأذنابهم
الرّفاق العفالقة؛ ووارثيهم من أيتام “الثورة” السّورية”.
هي محاولة موفقة من الكاتب في أن يجمع في أطراف الألم المبتورة في جهاتها، أن يلملمَ ويختزلَ الألم في صوره التّاريخيّة، بين ماض وحاضر يجمعهما القتل والخيانات، الماضي البعيد مع الحاضر القريب في وجه متكامل للخيانة، من أطرافٍ أسهمت وما زالت في الجرح النازف، هذا الاستحضار من الكاتب لألقاب الطغاة، واستثمارها في النّصّ، وبطريقة متتابعة تاريخيّاً حتى “الثورة” السورية، والتي ــ ربما ــ يتبرأ الكاتب من توصيفها الحقيقي، طالما وضعها بين تنصيصين. فلا حاجة لجهد تأويليّ أمام القارئ ليفتتح عقود الألم الكردي، بهذا الاسترجاع يتعمدُ الكاتب للإيحاء إلى جملة تواريخ، مضت وبعضها ما زالَ الدمُ طرياً عليها، ورائحتها في ذاكرة القارئ الكردي وحتى السوري، يعايشُ تفاصيلها، التي تتراءى أمامه صورها، من بلاد ومدنٍ تتجزأ، تتحوّل، وتُصادرُ بيوتها ومساكنها، ويُخرجُ أهلها من أرضها، إنّه الفقدان بأبشع صوره.
الكاتبُ يغورُ لقرونٍ بعيدة، ــ أو ربما كادت تقتربُ ــ حيثُ السلطنة العثمانية بقوة سيوفها ورايتها الخضراء بالأهلة الثلاث، غزت العالم ولربما تريدُ أن تعيد التاريخ لعظمتها بقوة السيف، ولتحطمَ صورة الإنسان أو الكردي تحديداً، أمام ذاته التي تسعى كلّ يوم لتثبتَ هذا الحضور العميق أمام العالم أجمع “إنْ كان للجميع قيامة واحدة، فإنَّ الكرديات قياماتهنّ مستمرة”، هكذا بتتابع تاريخي، يأتي به الكاتب للطغاة والدكتاتوريات وصولاً إلى مأساة السوريين، وباختزال وخطاب توصيلي/ تقريري، يقدّمُ الكاتب نصهُ، حيث لا استعارة ولا رمز ــ إلا فيما ندر ــ ولا نيّة لدى القارئ أن يقوّلَ النّصّ خارج سياقه الأدبي.
وبنصٍّ قائم على عدة مستويات سرديّة، ينحازُ الكاتب مرّة للوصف، ومرّة لسردِ جملة من الأحداث التاريخية، وثالثة ينحاز لوصفِ الكرديات، يسردُ بكل حيادية ومباشرة، وبأسلوب الحوار وبشكل دراميّ قصصهن، وكلما توغّلَ القارئ في عمق النصّ، تنكشفُ له فضاءات قصص ألمهنّ الواسعة، حيث الصور والتوصيف المشحون بالدّم والآهات.
واللغة في كامل النصّ كحالة ولادة، مخاطها الألم، بمعجم وحقل مفرداتي قائم على الألم والبتر والدّم، ألم المكان والزمان لشخوصها، يحضران مع الكاتب/ الطبيب وهو يسردُ الألم، ينحتُ في عظام زائريه وهو يبترها، ويحوّلها لألم متجدّد، يفكّ قيودها من العظام، لتتحوّل إلى أناشيدَ على لسان الحبيبات، الأمهات، الأخوات، والصديقات، إنّهُ ألمهنّ، الألم الذي لا شهوة فيه ولا إثارة سوى مشهد الدّم على يديّ الطبيب الغارق في الأنين وتأنيب الضمير “يوم وفاة ابنها ــ للأسف ــ وقفت يدايّ عاجزتين عن تقديم أي عون لابنها لبشاعة إصابته، سوى إعطائه 300 ملليلتر من دمي، والانتظار حتى يسلم روحه لبارئها، لا زلتُ أتمنى أن تُبترَ ذراعيّ وتُدفنا“، إنّهُ الكاتب/ الطبيب ــ ذاته ــ العائم في مآسي مدنٍ عايش وجعها وعتمتها، اختزلَ صلابتها ونزف جراحاتها من مهاباد إلى عفرين مرورا بشنكال ..!!
هنا تكتملُ عمليّة التّلقي وفعل القراءة، هنا تكتملُ مواجهة الألم والموت، عندما يُنهي الكاتبُ النّصّ بمقولة: “من البقية العاشقة لسوريا”، هو لم يذكر صراحة اسمه ولم يتكئ على ضمير الأنا المخفي هناك، ثمة حذف واضح في الجملة، وهو الضمير المنفصل الحاضر الغائب (أنا)، جملة خارج النّصّ، ومقطع مستقل عنه، ولكنه يُشكّلُ جزءاً مهماً للنصّ، ووحدة نصية تعملُ بفاعليّة مع النّصّ أعلاه، إذ يترك وراءه جملة من التصورات والتعالقات. هو رهان الكاتب/ الطبيب ــ رهان كلّ السوريين ــ رهان بقائه، رهان العشق الذي لا يكتملُ إلا بالأنثى الكرديّة، فللعشقِ ألف وظيفة وبقية، العشقُ الذي تُسعفُه الجملة لترتفعَ وتعلو وترتبط مع النصّ بعقدٍ صارمٍ.
إنها الكتابة والقراءة التي تستندُ على الألم وحده، ولأجلهنّ فقط، لدمهنّ وهو بلون الحناء على شعرهنَّ “حِناءُ شعرهنَّ المبيض باكراً، حُمرةُ دماء أحبتهنَّ، حمرةٌ صافية لا شائبة فيها”. الألم الذي لا يقلُّ عن فاجعة صاحبة الجديلة ..!!