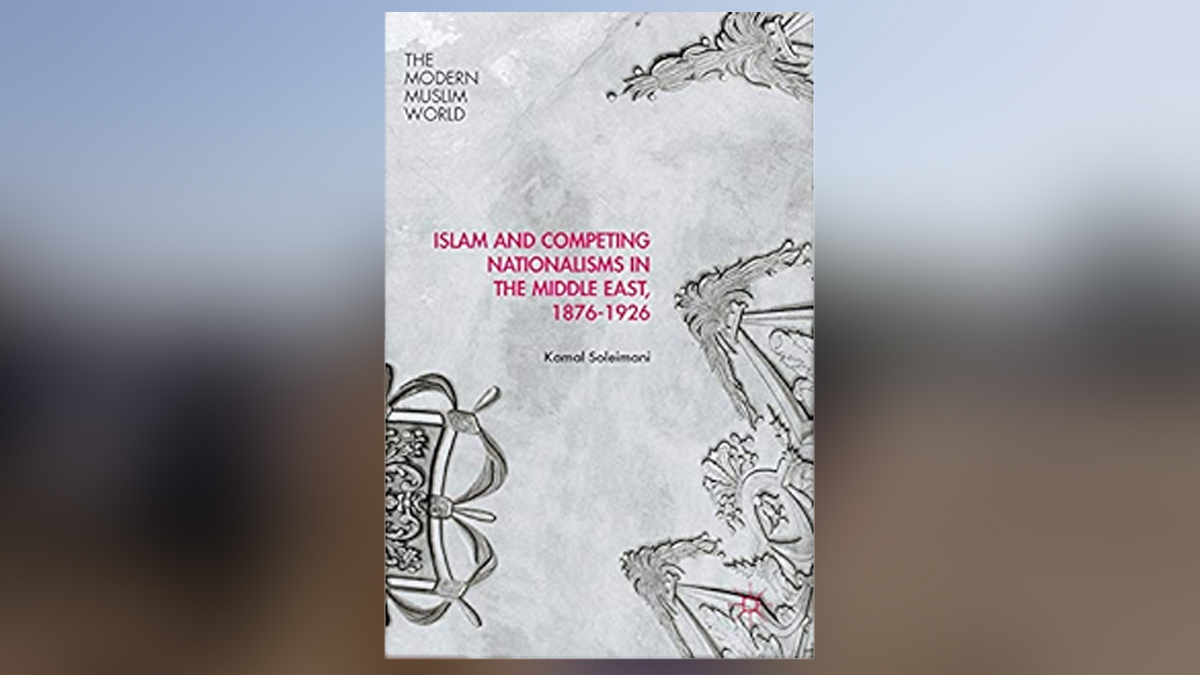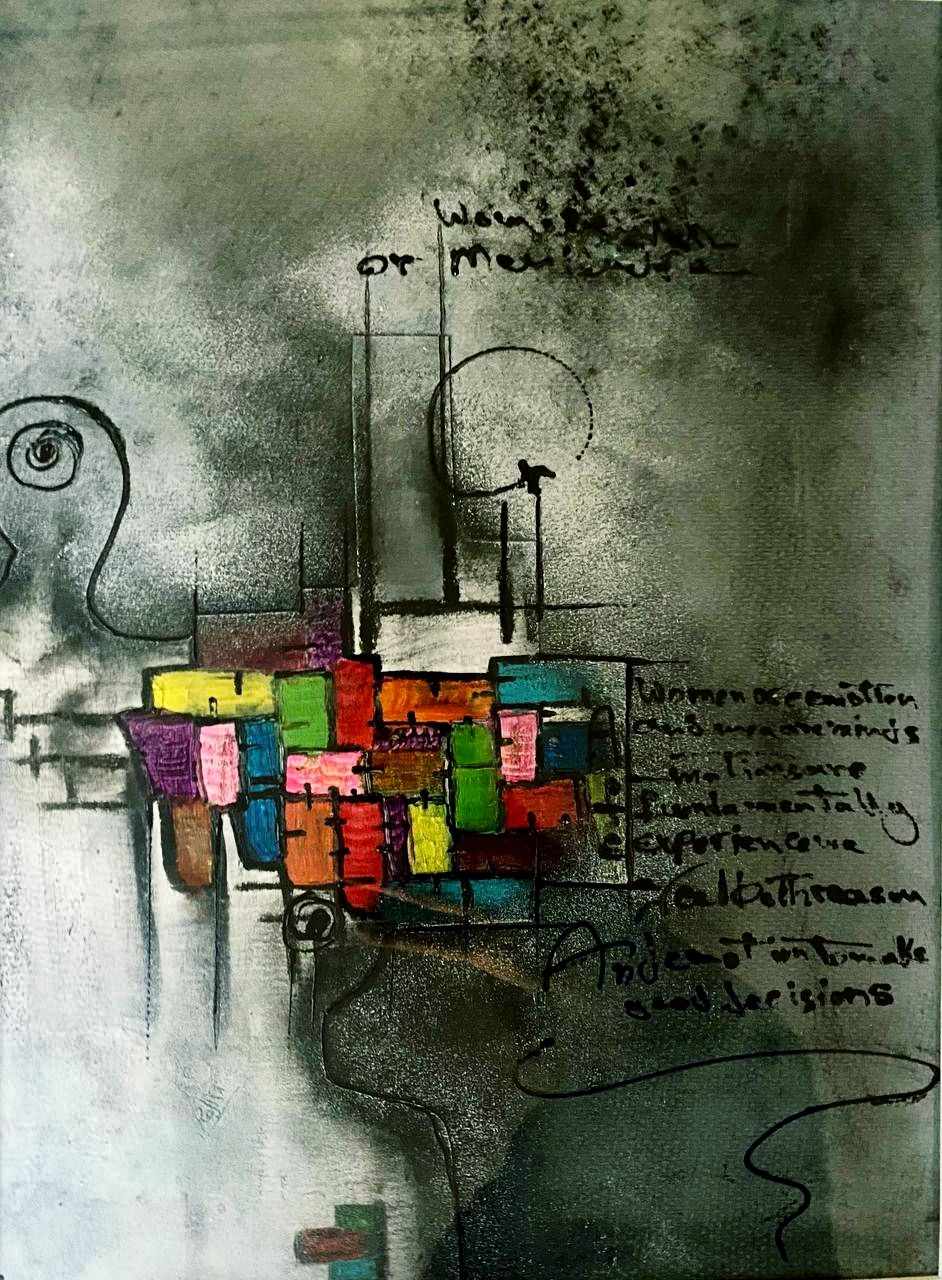تأليف: شيري لايزر
أرامل بارزان
في أعقاب انهيار الثورة الكردية في عام 1975، أخذت قوات صدام حسين سكان نحو 1800 قرية من منطقتي برزان ومركه سور، ومعظمها تنتمي لعشيرة بارزان، إلى جنوبي العراق. استمروا بالعيش هناك حتى 1978 حيث نُقِلوا مرة أخرى إلى شمالي العراق في معسكرات اعتقال أُقيمت في أربع مواقع رئيسية هي ديانا وحرير وبهيركا وقوشتابه. وقد أطلقت الحكومة العراقية تعبيراً لطيفاً هو “القرى النموذجية” التي بلغ سكان كل واحدة منها نحو خمسين ألفاً. أما القرى في منطقة بارزان فقد دُمِرت تماماً.[1]
خلال الحرب العراقية- الإيرانية تكبد الجيش العراقي خسائر كبيرة في حاج عمران في الثاني والعشرين من تموز/يوليو، إثر غزو القوات الإيرانية لكردستان العراق. ووفق أحد التقارير الكردية عن القضية فإن صدام حسين قام بزيارة لجبهة راوندوز من أجل القيام بهجوم معاكس ضد إيران. ونظراً لعدم قدرة العراق على طرد الإيرانيين من مواقعهم، فأنها ادعت أن (ح.د.ك) هو من ساعد الإيرانيين في حاج عمران. اعتبر صدام حسين، الذي اعترف بالتقدم الإيراني على التلفاز، أن مسعود وشقيقه إدريس البارزاني هما المسؤولان شخصياً عن ذلك. ونظراً لعدم قدرتها على الوصول إلى من اتهمتهم مباشرة، فإن الحكومة العراقية صبت جام غضبها وحقدها على 8000 كردي من عشيرة بارزان ممن كانوا يعيشون في ظل حمايتها[2].
في 30 تموز/يوليو 1983 طوّق الجيش العراقي المعسكرات الأربعة وأخذوا كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10-80 سنة. تم أخذهم إلى بغداد وكربلاء والنجف حيث عرضهم صدام على أنهم أسرى حرب من الجانب الإيراني قبل أن ينقلوهم إلى معسكر جديد بالقرب من الحدود الأردنية. في شهر أيلول/سبتمبر أُعتقل ثلاثة من أبناء ملا مصطفى البارزاني وتم إعدامهم[3]. ولم يُسمع أي شيء عن البقية رغم أن اللجنة التحضيرية للمفقودين في كردستان قدمت في 24 أيار /مايو مشاهداتها إلى الجلسة الرابعة والعشرين لفريق العمل عن الاختفاءات القسرية والطوعية التابعة للأمم المتحدة. وكانت اللجنة قد جمعت أسماء 2280 من أصل 8000 مفقود مع وصف لظروف ترحيلهم[4]. تم تبني قرار للتحقيق في القضية ومطالبة الحكومة العراقية بتقديم رواية رسمية عن اختفاء 8000 من الأكراد البارزانيين. في أيار/مايو أخذ العراقيون مرة أخرى كل الذكور المتبقيين في المخيمات الأربعة من عمر الخامسة فما فوق. في منطقة قره داغ، القريبة من السليمانية، نُقل بالقوة كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10-80 سنة حيث تم وضعهم في شاحنات عسكرية اتجهت بهم إلى الجنوب.
ولكن في عام 1983 أصبحت معظم النساء في بارزان “أرامل”. فقد بقين، نظراً لعدم توفر دليل على وفاة أزواجهن،يعيشن على أمل متسم باليئس بأن أزواجهن وآبائهن وأخواتهن سيرجعون في يوم ما حيث لم يكن متأكدات فيما إذا كان رجالهن قد أُعدِموا أو لا يزالون على قيد الحياة. توالت السنين وهن يعشن على أمل أن رجالهن سوف يعودون يوماً ما إذ طالما هناك شك ليس بإمكانهن أن يعلنن الحداد ولا أن يبدأن حياة جديدة لأن إعادة الزواج مسألة معقدة. لقد أصبحت تلك النسوة “شهيدات على قيد الحياة”.
في عام 1988 عندما سُئل صدام عن ذكور البارزانيين المفقودين، قال في تصريح متلفز أنهم ذهبوا إلى “الحفارين” (بمعنى آخر إلى المقبرة)[5] لكن ينبغي مع ذلك تحديد موقع الجثث.
إن ظروف “الأرامل” الاقتصادية كانت سيئة للغاية بعد أن تركن بدون رجال يعملون لهن على اعتبار أن الرجال هم عادة من يقومون بالكسب. أحيانا يتم استغلال تلك النسوة وبناتهن غير المتزوجات من قبل الغرباء. البعض منهن لجأن إلى الدعارة في البلدات القريبة من مخيماتهن لكسب ما يكفي من النقود للعيش ومن يحملن منهن يجدن أنفسهن في موقف يبعث على اليأس حيث يتم نبذهن من المجتمع ويُنظر إليهن على أنهن جلبن المزيد من العار على المجتمع. ومع انتشار البطالة الجماعية والافتقار إلى الضمان الاجتماعي في كردستان تعاني من الإفلاس فإنه ليس بالأمر البسيط إعالة آلاف الأرامل من البارزانيين.
وقد أخبرت بعض النسوة من قبيلة البازرانيين اللاتي يعشن في مخيم قوشتابه في أربيل ممن أقمن علاقات مع رجال من خارج القبيلة أو خارج الزواج أحد المراسلين في صيف 1993 “يعتقد الكثير من النساء أنه في تلك الحالة فإن القتل هو الحل الوحيد لتطهير ما سمّينه “القلوب غير النقية”. ويقول طبيب يعمل في مخيم قوشتابه أنه يعرف على الأقل عشرين حالة مشابهة في السنوات العشر الأخيرة.[6] لا تزال النساء تُقتل على يد أسرهن بسبب عدم الاحتشام جنسياً. لا المجتمع للإناث أن ينحرفن بإتجاه إقامة علاقات مثيرة للشبهة.
الحقول الخضراء المحيطة بقرية بارزان تموج بشقائق النعمان الحمراء كالدم حيث الكثير من البيوت بُنيت على أطلال البيوت القديمة والناس منتشرون في كل مكان. ولكن عند الاقتراب ترى بأن كل السكان هم من النساء. إن ذلك دليل على التراجيدية المزعجة التي لحقت بعوائل بارزان. ورغم جمال موقع قرية بارزان فإنه يبدو وكأن غيمة سوداء تُبقي المكان في الظل.
امرأتان عجوزتان تجلسان على عتبة باب بيتٍ مطلٍ على القرية وقد أُعيد بناؤه حديثاً وكلتاهما متشحتان بالسواد. يتدلى شعرهما في خصلتين طويلتين من الأمام بينما بقية شعرهما مرفوع تحت قلنسوة عباءتهما تماشياً مع زي النساء من عمرها في تلك المنطقة.
اقتربنا من المرأتين على أمل أن يتكلما معنا. انتشرت بعض الخرانق [صغار الأرنب] البيضاء عندما وصلنا إلى الدرج المؤدي إلى المدخل الأمامي المسقوف. فتاة جذابة تبلغ من العمر 14 عاماً ترتدي ثوباً أرجوانياً مزين بالورود البيضاء خرجت من البيت ووقفت مبتسمة ترحب بنا. وكان برفقتنا الدكتور لقمان، وهو طبيب يتكلم الإنكليزية من دهوك ومسؤول عن الرعاية الصحية في بارزان والقرى المحيطة بها . كان يعرف العوائل هناك ووجوده سّهل زيارة العوائل. انسلت الفتاة ذات الثوب الأرجواني إلى الداخل لجلب بعض المرطبات وظهرت في الحال مع صينية عليها أكواب عصير البرتقال المنعش. بدت المرأتان وكأنهما في العقد الرابع أو الخامس من عمرهما. ولكن كان من الصعب معرفة ذلك لأن المعاناة قد شيّختهما بلا شك بما يفوق عمرهما. تكلمت السيدتان بجمل قصيرة تنم عن الألم الشديد وهن يبحثن في ذاكرتهما عن كلمات يمكنها أن تصف ما حدث. ” عدتُ إلى بارزان في الخريف الماضي. كانت تبدو أجمل بكثير في السابق. كان هنا، ذات مرة، الكثير من الناس. كانت لدينا أسراب [من الدواجن] وقطعان نعيش منها، كان لدينا بيوتاً خاصة بنا ولدينا أسرنا ولدينا أيضاً مقتنيات خاصة بنا أما الآن فلم يبق شيء- لا أسر ولا ناس ولا حيوانات ولا حياة.” لقد تم أخذ خمسة رجال من أسرتها ولم يُسمع شيء عنهم.
ووضحت ” لا نعرف شيئاً عمّ حصل لرجالنا. لقد أُخِذوا جميعاً من قبل الحكومة. معنوياتنا في الحضيض ولكن لا يزال لدينا بصيص أمل. لا نزال نرجو من الله أن يعيدهم لنا سالمين… كان لدي أربعة أبناء. لدى إلقاء القبض عليهم كان أصغرهم يبلغ العاشرة فقط والآخر خمسة عشر أما الثالث فكان يبلغ العشرين وكان متزوجاً وله طفلين أما الابن البكر فكان يبلغ خمس وعشرين عاماً. كان هو متزوجاً أيضاً وله أربعة أطفال. لا نعرف لماذا تم أخذهم.
” حصل ذلك ذات صباح في حوالي الساعة الخامسة. من كان مستيقظاً كان قد نهض من أجل الصلاة أما الآخرون فكانوا لا يزالون في فراشهم. جاء الجيش وطوّق قريتنا. أمر جنود صدام الجميع أن يخرجوا ثم جمعوا كل الرجال وأخذوهم معهم. من كان مستيقظاً أُخذوا أولاً ثم بحثوا عن النائمين وأخذوهم من فراشهم.
“كانت الحكومة تنظر إلينا كأعداء لها. لقد أرادوا أن يطردونا وأن يجبرونا على الذهاب إلى المخيمات. بالطبع لم نكن نريد الذهاب. ولكن ماذا كان بوسعنا أن نفعل؟ لقد أجبرونا على ترك قرانا وبيوتنا. بعد ذلك كان يجب علينا أن نعيش في المخيمات التي بنوها لنا.
” في إحدى المرات جاءوا إلى المخيم الذي نُقلنا إليه في الليل وطوقونا كما في السابق. ثم جمعوا كل الرجال الذين كانوا هناك حتى من كان مريضاً أو مصاباً منهم بل حتى المجانين والعميان. ربط الجنود أرجلهم بالقوائم الخلفية للدواب وسحبوهم. لم يبق أحد ولا واحد على الإطلاق. أقسم بالله لم يبق في القرية كلها بالغٌ كبير بما فيه الكفاية كي يذبح دجاجة[7]. لقد أخذوا الجميع وأسقطوهم في الشاحنات وذهبوا بعيداً. سنة بعد أخرى تُركنا نحن النساء لوحدنا بحيث نغسل موتانا ونحرس مخيماتنا بأنفسنا.
“كيف يمكننا أن نسامح من فعل هذا بنا؟ لا يمكننا أن نسامحهم أبداً. لقد دمروا بيوتنا ودمروا حياتنا. من يستطيع السماح؟ سوف نستمر في العيش على أمل أن نرى رجالنا مرة أخرى طالما نحن على قيد الحياة.”
امتلأت عيناها بالدموع. ولم تحاول أن تمسحها. وبدأت تنظر إلى الأفق ولم تعد ترانا.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط (ميدل ايست ووتش) و أطباء من أجل حقوق الإنسان الذين وثقوا الإبادة بحق الأكراد يعتقدون أن:
“معظم، إن لم يكن كل، من اختفوا خلال عمليات الأنفال قد قُتِلوا من قبل قوات الأمن العراقية…الناجون من الأكراد وهم نساء وأطفال ومسنين تم نقلهم بالشاحنات في حالة من الحرمان والجوع الشديدين من القلاع إلى مناطق في جنوبي كردستان. تم زجهم بعشرات الآلاف في مخيمات تفتقر إلى الطعام والماء والمأوى والرعاية الطبية. كانت تلك المخيمات ببساطة أرض خاوية يقوم بحراستها الجنود في الأبراج. مات الكثيرون ومن بقي منهم على قيد الحياة بقوا أحياء بفضل المؤن الأساسية التي كانت تُجلب إلى المخيمات من قبل الأكراد في البلدات المجاورة.”[8]
وقد قال أحد الشهود العيان الذين شهدوا الترحيل القسري للرجال الأكراد من تلك المخيمات كيف أنه “من الثاني والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر تموز/يوليو 1983 كان يمكننا رؤية مرور الأرتال الطويلة للشاحنات العسكرية والمصفحات والطائرات المقاتلة باتجاه الشمال… أشياء غير اعتيادية كانت تحصل…نحن، سكان مخيم قوشتابه، لم لدينا سبب وجيه للخوف ببساطة لأننا مدنيون ولم نقم بأي نشاط ضد النظام. لقد تدرب البعض من شبابنا في مخيمات الحكومة العسكرية وكان البقية مشغولون بالأعمال اليومية لإعالة أسرهم. لم نكن نتوقع أية أعمال انتقامية جماعية بسبب ما يحصل في حاج عمران…في الثلاثين من تموز/يوليو استيقظت زوجتي كالعادة من أجل صلاة الفجر وتحضير الفطور لنا. في ذلك الصباح أُوقظت على يد زوجتي وهي تنهرني بقوة. بدت مرعوبة وقالت:” لقد تم تطويق مخيمنا من قبل الجنود العراقيين، نحن في داخل حلقة من العربات المصفحة.”
بعد ذلك دخل الجنود إلى المخيم وبدءوا بإطلاق النار واقتحام الأبواب. ركض الأكراد للاختباء ولكنهم كانوا يُضربون بشدة ويُسحبون بمجرد اكتشاف أماكنهم. كان هناك حوالي 20 ألف نسمة في ذلك المخيم الذي كان في حالة من الجلبة والضجيج. في حوالي الساعة الحادية عشر ة والنصف من ذلك الصباح، يتذكر الشاهد، لم يكن قد بقي ذكور ما بين عمر 12 إلى 80 باستثناء الذين نجحوا في الاختباء من الجنود الهائجين في الأفران والبراميل أو أي أماكن أخرى للاختباء. تمكن الراوي من الهروب في نفس تلك الليلة واستمر في المشي في الأيام الأربعة التالية عبر الجبال ليصل إلى بر الأمان.[9]
تجولنا ببطئ عبر أزقة موحلة بين البيوت باتجاه بساتين ذات أشجار مكسورة حيث أزهرت أزهار برية حول جذورها. جلستُ على صخرة كبيرة على أطراف التلة الخضراء التي تطل على المصاطب الحجرية لكروم بارزان. لم يتكلم أحد منا فقوات صدام على بعد عدة أميال مما ترك الأرامل يتساءلن فيما إذا كان الجنود سيعودون مرة أخرى ويدمرون من جديد كل ما تم إعادة بناؤه.
حكاية سروه عن مجزرة حلبجة
“كان ذلك في الثالث عشر من آذار/مارس حين بدأت إيران تقصف ضواحي حلبجة. في اليوم التالي كان صوت القصف أقرب وضربت عدة قذائف البلدة نفسها. بلغتنا أخبار أن إيران قتلت عدداً من الأكراد في تلك الهجمات.
في ذلك الوقت كنت مدّرسة أحضّر الأوراق للامتحانات. كان من المفترض أن تبدأ الامتحانات في السادس عشر من آذار/مارس. كان الجميع يحضرون بجد لتلك الامتحانات وأذهاننا كلها مركزة عليها. ورغم أنه كان هناك بعض الانقطاع في المدرسة بسبب القصف، إلا أنني كنت أذهب على أية حال من أجل إنهاء الامتحانات لطلابي.
إحدى زميلاتي، واسمها بري، كان حامل في الشهر التاسع. تركتنا في الثالث عشر من آذار/مارس قائلة كم ستكون سعيدة أن ترانا في بيتها بعد أن تكون قد وضعت المولود. كنا سعداء من أجلها وحتى القصف الإيراني لم يؤثر على معنوياتنا. قبّلتنا بري بحنان وغادرت المدرسة.
في ليلة الخامس عشر بدت الأشياء في حلبجة غير طبيعية. فقد لاحظنا أن بعض البيشمركه من (ح.د.ك) والحزب الإسلامي بقيادة ملا علي قد جاءوا إلى البلدة. كان ذلك شيئاً غير طبيعي البتة حيث أن حزب البعث كان قد تخندق بيننا وكبار مسؤولي حزب البعث من الأمن والمنظمة (مقر حزب البعث السياسي) اختفوا ولم نسمع أن أي منهم قد قُتل. لابد أنهم خبروا مسبقاً بنوايا صدام وغادروا البلدة. فقط مجندو الجيش العراقي الإلزاميين من فرقة الدبابات بقوا في مواقعهم لصد أي هجوم إيراني. كانوا جائعين ومعنوياتهم في الحضيض.
كان مساءً ربيعياً دافئاً والناس جالسين في الخارج. كنا نتكلم مع البيشمركة عن آخر المستجدات. كانوا يتكلمون عن تحرير السليمانية وأجزاء أخرى من كردستان وأخبرونا” أنتم الآن أحرار في حلبجة”. كان لديهم فقط البنادق الروسية كلاشنيكوف وما من أسلحة ثقيلة برفقتهم. كان الناس مندهشون ولم يعرفوا من يصدقون.
كنتُ قلقة وغير قادرة على النوم بسبب الجو المشحون جداً من حولنا. كان لدينا إحساساً أن شيئاً ما على وشك الحدوث. كنتُ قد عدت إلى البيت في ذلك المساء في الساعة الحادية عشر مساءً بعد أن استمعت إلى الأخبار وجمعت أشيائي الثمينة من مصاغ ونقود ووثائق شخصية لي ولزوجي كمال. كان لديه هو وأفراد عائلته الذين نعيش معهم نفس التوجس أيضاً.
في صبيحة السادس عشر من آذار/مارس سألتُ كمال فيما إذا كان ينبغي علي أن أذهب إلى المدرسة حيث أنه يوم الامتحانات. ظننت أن الطلاب قد يصلون لتقديم امتحاناتهم. لم يحبذ كمال تلك الفكرة حيث أن البيشمركة لا يزالون منتشرين في البلدة وليس هناك موظفون حكوميون وأصوات القصف من جانب إيران لا يزال قريباً.
على أية حال ذهبتُ إلى المدرسة لأنها قريبة من بيتنا. كان يوماً مشمساً لكن الجميع بدوا متوترين. الكثير من النساء كن قد بدأن بحزم ممتلكاتهن وتجميع أسرهن كما لو كن على أهبة الاستعداد لمغادرة البلدة. لم أر أياً من طلابي ولا المدّرسين الذين معي في المدرسة.
عندما وصلتُ إلى المدرسة كان قفلاً كبيراً قد وُضع على الباب الخارجي. عدتُ إلى البيت مسرعةً وأنا أشعر باليأس على كل ذلك العمل الذي ذهب هباءً ووضعتُ أوراقي جانباً. كانت القنابل الإيرانية تسقط على بعد عدة كيلومترات. شعرتُ بالقلق وأردت أن أعرف ما الذي يجري. كانت عائلتي على بعد عدة ساعات مني في السليمانية وخفتُ ألا أتمكن من رؤيتهم من جديد. قررتُ زيارة صديق مع كمال لنرى إن كان أي شخص ذاهب إلى السليمانية.
عندما وصلتُ إلى بيت صديقتي كانت هناك صديقتان أخرتان أيضاً. قالوا لي أن لا أحد يستطيع الذهاب إلى السليمانية لأن إيران تقصف الطريق هناك. أراد آخرون التوجه صوب الحدود الإيرانية لكن البيشمركة منعوهم من الذهاب أبعد من ذلك مكررين أنهم الآن محررون في حلبجة ويجب أن يبقوا فيها. تجمع عدة أشخاص آخرين عند بيت صديقتي لأنه يوجد فيها ملجأ للوقاية من الهجمات بالقنابل. كان لدى معظم البيوت في حلبجة ملاجئ أو غرف تحت الأرض لأن الحرب العراقية-الإيرانية مستمرة هناك منذ وقت طويل. بعد نحو ساعة من التشاور مع الأصدقاء قررنا أنا وكمال العودة إلى البيت. كانت أبواب المحلات مغلقة والأسواق فارغة وجموع من الناس واقفون أمام منازلهم ليروا ما هو أفضل شيء يمكن أن يفعلوه.
كان الوقت لا يزال مبكراً، حوالي العاشرة صباحاً. لكن كان هناك الكثير من الحرس الثوري الإيرانيين والبيشمركه في الشوارع كما لو أن هناك استعراض عسكري. كانوا مسلحين وعلى أهبة الاستعداد للقتال. كان البعض يركبون البغال وكانت بعض البغال محملة بالأسلحة. كانت تلك أول مرة أرى فيها الحرس الثوري عن كثب وشعرت بالخوف. عندما وصلت إلى البيت كانت حماتي قد أعدت طعام الغداء فجلسنا لنأكل. كان الجميع قد شاهد الحرس الثوري مع البيشمركة. عندما أنهينا الغداء ذهبتُ مع أخت زوجي لغسل الصحون عند صنبور المياه الذي في الحديقة، حيث لا توجد مواسير مياه في المطبخ. كانت العائلة في الداخل تشرب الشاي. سمعتُ صوت طائرات تقترب. بعد لحظة ضُرِب الحمام المجاور للحديقة بقنبلة من أعلى. كان في الأعلى ربما حوالي ثمان طائرات. ولكن لأن منزلنا قد ضُرِب فإن الجو امتلأ مباشرة بالغبار فلم أتمكن من رؤية أي شيء آخر. ما سمعته فقط هو صوت انكسار الأطباق وصوت زوجي وحماتي وهما يصرخان من الداخل لأنهما يعرفان أننا على مقربة من المكان الذي أصابته القذيفة. غطيت عيني وجلست القرفصاء في زاوية الحديقة حتى تلاشى الغبار. عندما صفيّ الجو انسحبت الطائرات أيضاً. لاحظتُ أن أجزاء أخرى من البلدة قد ضُرِبت أيضاً. وبما أنه ليس لدينا ملجأ خاص بنا، قررنا ترك المنزل وذهبنا مباشرة إلى جارنا المقابل في الشارع حيث لديه ملجأ. لاحظنا أن منزلين أو ثلاثة منازل أخرى في نفس المنطقة قد دُمّرت أيضاً بالقنابل.
الكثير من جيراننا كان قد اجتمعوا في ذلك الملجأ عندما وصلنا. كانت عيونهم تطفح بالخوف. البعض منهم جلب معهم بطانيات ومصابيح وشموع والبعض جلب الخبز. وآخرون جلبوا أشياءهم الثمينة. كان هناك صخب وألقى بعض الناس اللوم على البيشمركة الذين جلبوا الحرس الثوري وحولوا حلبجة إلى ساحة حرب. بدأت الطائرات تأتي كل بضع دقائق وتقصف بدون انقطاع.
في الأسفل تكومنا على بعض في زاوية بدون حركة وصوت مخبئين رؤوسنا بين أيدينا حتى تلاشى هدير الطائرات. كان هناك نحو مائة شخص يدوسون على بعضهم والهواء خانقاً. الأطفال الصغار يصرخون والجميع ينادي على الجميع. فجأة بدأت القنابل تنهمر على البيت الذي يكون الملجأ تحته. لم يكن هناك باب للملجأ بل فقط بطانية لذلك امتلأ الملجأ بالغبار وقطع من الإسمنت المتطاير. نهض بعض الناس ليروا ماذا حصل: كان المنزل قد دُمّر بقنبلة. والطائرات لا تزال تحلق هناك بدون توقف. رجعوا بسرعة ولم يكن هناك وقت حتى لتغيير أمكاننا. كانت الطائرات تحلق على علو منخفض وتخترق عمداً جدار الصوت. توصلنا إلى اعتقاد أن صدام لا ينوي هذه المرة أن يُظهر لنا أية رحمة.
فجأةً شممنا رائحة مميزة تشبه إلى حد ما غاز الطبخ ولكن فيه شيء مختلفاً أيضاً. وفي الحال بدأ يؤثر على تنفسنا. كنت قد سمعتُ أن صدام استخدم الأسلحة الكيميائية في قره داغ ليس بعيداً عن حلبجة. وكنت قد قرأت أيضاً أنه في حال التعرض للهجوم بالأسلحة الكيميائية ينبغي فوراً تشريب قطعة قماش بالماء وتغطية الوجه بها. راودتني تلك الأفكار بلمح البصر في تلك اللحظة. طلبتُ من زوجي أن يجلب بسرعة قليلاً من الماء. قال شخص جالس بالقرب مني أنه ربما يكون تسرباً للغاز من المنزل، لكن زوجي فعل كما طلبت ورجع ومعه سطل كبير من الماء. أخبر زوجي الجميع أن ينقعوا بطانياتهم وملابسهم بها وذهب مرة أخرى لجلب المزيد من الماء.
بعد نحو نصف ساعة قررنا أن نهرب من ذلك الملجأ رغم أن الطائرات كانت لا تزال تأتي وتقصف البلدة من كافة الجهات. في الخارج كان كل شيء قد تغير. لم يعد المكان كما كان. كانت البيوت تحترق والنيران مشتعلة في الغاز المسرّب نتيجة القصف. الناس يركضون في الشوارع وهم يغطون بيأس وجوههم. أنا أيضاً استمريت في تغطية عيني وفمي بالقماش المبلل وركضت باتجاه ملجأ نعرفه يقع تحت مبنى عام بعيد عن مركز المدينة. وأنا أركض لمحتُ رجلاً مستلقياً على الرصيف وهو يشهق. عرفنا أنه تأثر بالأسلحة الكيميائية فلم نتمكن من الوقوف لمساعدته. بعده بقليل رأينا سيدة عجوز وقد فارقت الحياة. لم يكن هناك دم أو آثار إصابة عليها. كان وجهها شاحباً ورغوة بيضاء تتدفق من طرف فمها.
الملجأ الذي قصدناه كان يقع تحت مبنى حكومي. كل السكان في المنطقة المجاورة كانوا قد ذهبوا إلى هناك معتقدين أنه يقدم حماية أفضل من الهجمات الجوية التقليدية. كان هناك حوالي 500 شخص عندما وصلنا إلى هناك. لم يكن أحداً منهم يعرف شيئاً عن الهجمات الكيميائية ولا شموا شيئاً كذلك الغاز في المنطقة. لم يكن هناك مجال في الملجأ حتى للجلوس. خطر في بالي حينئذٍ أنني نسيت حقيبة اليد خاصتي وفيها كل الأشياء الثمينة التي نملكها. أصرّ زوجي على الذهاب لاسترجاعها حيث أننا لم نكن نملك فلساً واحداً ونفكر بالهروب إلى الحدود. عندما عاد كمال مع الحقيبة إلى الملجأ المزدحم، قال أنه رأى ما لا يقل عن عشرة جثث ملقى في الشارع. وعند الدخول إلى المنزل لاحظ كمال أيضاً أن كل الدواجن والديكة الرومية قد استلقت ميتة على الأرض. حينها كنا متأكدين أن الأسلحة الكيميائية قد استُخدِمت في ذلك الصباح ضد حلبجة. نظرت إلى زوجي ورأيت أن شفتيه ووجهه بالكامل شاحب كالموتى.
كان يمكن سماع الطائرات وهي تتقدم بسرعات هائلة. وعندما تحلق فوقنا وقريباً منا، كنا نسمع أصوات القذائف وهي تسقط. في الحال تقريباً استطعنا أن نشم الغاز. “هذه قنابل كيماوية. لقد ضُرِبت منطقتنا بها من قبل. يجب أن نغادر هنا حالأ.” قلنا لهم محذّرين. لكن البعض منهم كان لا يرغب أن يصدق تلك الفكرة غير القابلة للتصديق وأجابوا:”هذا المبنى محصّن بشكل جيد. نحن آمنون هنا.” لم يصدقوا أن منطقتنا ضُرِبت بالغازات الكيماوية وأنها قادرة ببساطة أن تنفذ إلى داخل ذلك الملجأ.
بدأت أشك أن خطة الحكومة تقضي أن تجعلنا نعتقد أن القصف يتم بقنابل تقليدية حتى يختبأ الناس في ملاجئ كهذه حيث سيلاقون حتفهم حالما يتم استخدام الغاز. خلال لحظات بدأ الناس بالسعال والشهيق. وبدأ آخرون بالإقياء. خرجنا بسرعة. كانت الساعة قد بلغت السادسة ولكن بما أنه ربيع فإن السماء لا تزال مضيئة. خارج المبنى رأينا صنبور ماء وعليه خرطوم. قام كمال برش الماء على وجوهنا. كنا نسأل عن حال بعضنا؟ هل أنت بخير؟ ماذا يحصل معك؟
بدأتُ أشعر بالدوار. بالكاد كنت أتنفس. كنت مذعورة لدرجة أن قدماي كانتا تحملانني بصعوبة بالغة. ورغم أننا رأينا بعض البيشمركة الذين كانوا يدلون الناس أين يذهبوا، لم نرَ أي من الحرس الثوري.
حينئذ عرفت أن صديقتي بري، زميلتي المدّرسة، قد قُتِلت في الدفعة الأولى من القصف. كان زوجها وابنها قد غادرا الغرفة للتو عندما سقطت القنبلة. لم يكن زوجها قادراً على إنقاذها من تحت الركام. آخذا معه ابن بري الصغير، هرب زوجها إلى جزء آخر من المدينة علّه ينقذ نفسه وابنه. ولكن هناك أيضاً بدأت القنابل تتساقط وكانت قنابل كيماوية فلم يتمكن أحد من النجاة”.
يتبع …
________________________________________
[1] تقرير عن التقدم في [ملف] 8000 كردي مفقود في العراق-الأمم المتحدة تتبنى القضية، تأليف اللجنة التحضيرية للمفقودين في كردستان، لندن، أيار/مايو 1988، ص10
[2] تقرير للجنة التحضيرية: اختفاء ثمانية آلاف مدني كردي في العراق-ماذا حصل لهم؟ لندن، تشرين الثاني، 1987، ص8.
[3] السابق ص8-9
[4] السابق. أيضاً من رسالة من جواد الملا إلى فريق العمل عن الاختفاءات القسرية والطوعية التابعة للأمم المتحدة، مركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 23 أيار/مايو 1988. اللجنة التحضيرية عن المفقودين في كردستان، تقرير عن التقدم في [ملف] 8000 كردي مفقود في العراق- الأمم المتحدة تتبنى القضية، ص9-11.
[5] فيصل داغلي، الاقتتال الأخويBrakuji , Belge Yayinlari, 1994 p.48
[6] كلير بوينتن “أم المآسي” مجلة تايمز، 13 آذار/مارس 1993 ص21.
[7] في الشريعة الإسلامية فقط الذكور يستطيعون أن يذبحوا الدواب. ويجب أن يكون الذكر قد وصل سن البلوغ قبل أن يكون محلّلاً له القيام بذلك.
[8] لقاء في برنامج الدم والانتماء بي بي سي 2، 1993.
[9] تقرير اللجنة التحضيرية، تشرين الثاني /نوفمبر 1987، الملحق ص 14-16 شاهد مجهول الاسم.